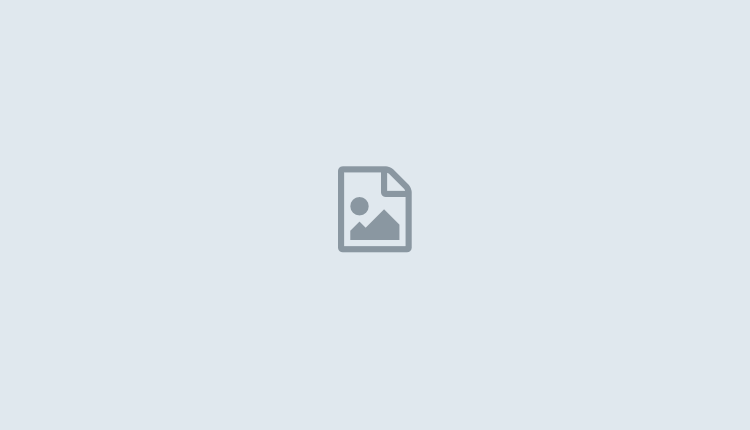رمـاح بوبـو، في شذرات الشمع المُحترِق ..جزءُّ أول
رماح شاعرة مؤمنة من انّ الشعر نقيض العِلم ، هدفه يُكتب فيلقى في سموت العالم بفنتازيا لاتعطي الحقيقة المطلقة . هو طريق الوصول الى الجمال على طريقة الألماني (غوتة) حين سألهُ أحدهم ساخراً مافائدة الشعر قال : أنه جميل وهل هذا لايكفي .. جميل مثل الشجر والعصافير والعطر والحب والسماء والنجوم .. لكن الجمال ياصاحبي يتوقف حين يصبح ذا فائدة . أنه من أحد أهم الأقوال العظيمة على مر التأريخ .
وأنا أقرأ لرماح أرى وكأن البيضة كسرت من الداخل فاعطتني الحياة على عكس مما لو كسرت من الخارج فتعطيني الموت والهلاك . رماح مقتدرة في ميلها للصنعة الأدبية الرابطة للهوة الشعرية مع الحكايا . بعيدة عن ظاهرة تضخيم الأنا والأنوثة . بعيدة عن بواطن الحداثة التي تضمر في دواخلها الرجعية والتخلّف بل هي الحداثة الناصعة . شاعرة لايمكن لها أن تكون إبداعا هباءاً ، هي الذاكرة الممتدة في قلوب المئات من القرّاء ، فلايمكن لها أن تذهب سدىً وإذا ذهبت فهي الشاعرة والروائية الفرنسية ( سيدوني كوليت) التي إنتزعت حقها في الإبداع فكان لها النجاح . شاعرة نثرية بإمتياز ، تجيد بشكل كبير كتابة النص المفتوح ثم النص السردي ، زاهية في الشفافية مع كل مايعتمر في النفس من حزنٍ وألم على وطن تشظى بسبب الحروب . كل ذلك كان واضحا في إبداعها ، جليا في البوح الوجداني والغنائي المشبع بواقعيته وبما ترمي اليه وهي تعزف أجمل ألحانها على أوتار الوطن الأم (الأرض) أوالأم كبايولوجيا التي غنى لها الشعراء في أمصارٍ عديدة .
بعض ماتكتبه رماح فيه نوع من السوريالية والتأويل ، ولربما هذا يتأتى لكونها إمرأة شرقية لاتريد الإفصاح بالشكل العلني فيما يدور في خلدها ، لكنها في جانب آخر تلك المرأة التي تقدح وضوحا فوق رداء الكلمات المقتسبة والمستعارة من اللغة المحلّية للواقع السوري المتداول كما سيأتي لاحقا . كذلك إستطاعت أنْ توصل رسالتها الى أبعد الأماكن والى النفوس التواقة لتغيير مانعيشه في شعوبنا من أمراضٍ وأدران تقليدية سائدة أو مخلوقة في ذات الأوان ، فها انا العراقي قد إستطاعت رماح السورية انْ تغرز في داخلي شيئاً مما تقولهُ فيثيرني فأكتب عنها وأنا البعيد كل البعد عنها جغرافياً . ولذلك أرى أنه من حق الشاعر أن ينحى للتورية والغموض ولكن دون التوغل العميق الذي يحجب المعنى عن بعض القراء المتلهفين للمعرفة الثورية الآنية لا الإنتظار المريرالناجم من فك شفرة النص والهدفيّة المتخفية وراء أجمة الرمزية .
رماح متوجسة أحيانا ، حذرة في إختيار المفردة ، لكننا نستطيع تصنيفها ضمن شعراء نيل المطالب بالغلابة لا بالتمني . مهندسة لكنها إتخذت مسلكيات الحرف واليراع الذي لايسلم صاحبه من الأرق وطلب العُلى . شاعرة تمسك بالذاكرة التي صيّرتها كراتبٍ تقاعدي للنفس الصديعة . لها طقوسها المتميزة في العديد من نصوصها الإنفعالية ، ذلك الإنفعال الذي يحلحل اللغة كي يفتح أمامها فضاء دلالي جديد ، دلالات تقول لنا من ان العقل لايستطيع حسم الجدل وهذه من أهم سمات الشعر الحديث . إستطاعت رماح أن تخلق سهام الحرف ضد الموروث الوضعي ولذلك نراها تتوسّد على شميم التراب وحب الأوطان التي أبتليت بالحروب وماخلّفته من ثكالى على إمتداد الإنطولوجيا البشرية العنيفة ، لنقرأ أدناه الشذرة التي تؤكد مانقوله :
ما نفع قصائدَ
لاتطلُّ شرفتها
على الملح والخرزات الزرق
مانفعُ قامتي
حين
لا تقنصُ يمامةَ صدري
مواكب الشّهداء
يقول محمود درويش ، الشعر ماء العين ملح الخبز يكتب بالأظافروالمحاجر والخناجر ، ولذلك الشعر يجعل من صاحبه متماهيا مع مايكتبه فيجعله أسيرا للتواضع ومحبا لجمهوره فنرى رماح حين تنحني للآخرين وهي ماثلة لتقرأ قصائدها في أمسية ما ، لهي وربي ستطول قامتها حتما مع عرفانها بما تؤديه من دورٍ نبيل وسط هذه الدوّامة التي خلفت هذا الكم الهائل من الشهداء .، ثم تردفُ متمنية أن يطال صدرها الجرح بدلاً من أن يُطال قوافل الشهداء ، لأن كلمة الشهيد لغة عريقة وأول من أطلق هذه التسمية هم الرومان في ذلك العصر الذي أطلق عليه عصر الشهداء .
رماح حتى الآن هي أسيرة أوضاع قاتلة لكل ما هو جميل في مجتمع فحولي حلّت به الحرب فزادت الطين بللاً . رماح تنتمي الى كل ما يشيرالى السلام فزادها الشعر والفن سطوعاً ، لكنها مجبرة على إرتداء قصائد الثكنات العسكرية وأرديتها المريعة . لنرى رماح ونفهم ماتصرّح بهذا الصدد :
في هذا
الرّكام السوريّ
خلف تغريبة الثورات
علي يمين مبنى البرلمان
مابين عواجل الأخبار والصّور
لم يزل
بعدُ
يلهث
بشر!.
الحياة كوميدية لعينة مثلما صورها لنا الفلم (جوكر) الحائز على جائزة الأوسكار تمثيل البارع (يواكيم فيونيكس) و(روبرت دي نيرو) والسمراء ( زازي بيتس) إنتاج عام 2019 ومن إخراج (تود فيليبس) حيث نرى فيه كيف انّ الأنظمة الرأسمالية تُرغِم المرء على أن يخرج من دوائر الرحمة دون الإرتقاء الى الإنسان الذي أرادهُ التنويريون من أمثال فولتير ، روسو ، كانط . فبدلا من أن يكون الإنسان شفيعا رؤوفا نراه بهذا النكوص المتردي بين الحين والحين . وبين كل هذا المعترك الذي يصيب كبد الإنسانية وحقيقتها المرّة نرى هناك من يلهث من البشر وراء الحياة التي ماعادت تطاق .
وتستمر رماح في فيضها الثكناتي مجبرة لابطرة لأنها إبنة هذا التجلّي الذي تشهده كل يوم دون إستراحة تذكر أو توقف عن المضي في الدمار والإنهيار فتدلو بهذا الإستغراب في نصها أدناه :
أحبُّ الزّحام
تأسرني أغنيتي…
” والعشاق اثنين اثنين.. ما حدا عارفنا وين… ”
أسمعهم ، صوتهم مكتّظٌ بالنَّمال
دم حبيبي سال زكيّاً
فشدّوا ركابهم عليه
يا كَسرة القلبِ ، لو درى دمُه
أنّه.. سال عبث !
أصعدُ..باصُ المدينةِ ، مزدحمٌ بالصّمت
أثوابٌ كالحةٌ
بضع بدلاتٍ عسكريّةٍ
و سائقٌ ، لا يكفرُ ، لا يشتمُ
لا.. يلقي نكات !
أسأل المرأة قربي
خير ؟؟
تنظر باستغرابٍ ، ولا تردّ
هنا الشاعرة تبوح بقصائد التعلّق ، والشعور التراجيدي بصديق أو أخ أو حبيب مات في الحرب التي لاناقة له بها ولاجمل ، لكنها إمرأة تفضل المدينة الآهلة بالسكان والعشاق مع بعضهم يداً بيد أو إثنين إثنين ، وهذا التصور من قبل الشاعرة رأيتهُ مجسدا بشكل خرافيٍ جميل في براغ وعلى جسرٍ فوق نهر الدانوب الأزرق حيث تجمّع العشاق أثنين أثنين وكل يقابل وجه الآخر بحيث أحدهم يمشي للوراء في وقعٍ جميل وحبيبته تمشي على سجيتها ، فهم أرادوا أن يجسدوا انهم ينظرون الى بعضهم البعض الى الأبد ، انهم أرادوا أن تكون وجوههم لبعضها حتى أثناء السير في الشوارع الذي من المفترض أن يكون سيراً عاديا وكلُّ الى جانب الآخر مثلما سائرِ البشرِ بينما هو إرتأى مشياً الى الخلفِ كي يسيرانِ معاً وَجهاً لوجهْ لكي يشبعَ ناظريهِ منها هاهنا على الطريقِ وكأنه لم يرتوِ من وجهها في البيتِ ، وفي المقهى ، في المطعمِ ، فوق المصاطبِ ، في الحدائقِ وفي صالاتِ الإنتظار، في الفنادقِ حيثُ غرفِ النومِ الوثيرةِ ، فجاءا هنا وفي منتصف زحامِ الحسّادِ والسابلة ، يمشيان ببطئٍ كما الطواويسِ وبطريقةٍ تتناغمُ ودقاتِ قلوبهم كعاشقـَين ضاربين جمالات الطبيعةِ وبقيةِ الخلقِ طرا ، يتعانقان كلّ عشرةِ أمتارِأمامَ الحشرِ بلا مبالاة . أنهُ الحب وإبداعات جنونهِ فوق الهديرِ الدانوبي وفوق الجسر . فقلتُ حينها للنفسِ (الخطيّةِ ) كما قالها السيّاب في عالمه الغريب وهو يتجوّل في شوارع باريس ، قلتُ : كم من الفتيةِ والفتياتِ في بلادي تقابلوا لأجلِ غرسِ السكينِ في خاصرِها صوناً للعِرض وكم من الفتيةِ في بلادي تقابلوا وجهاً لوجه ، لأجلِ القتل الطائفي أو العشائري .
ثم تستمرالشاعرة بهذا المنحى المؤرق ، لكنها هذه المرة تجعل كلماتها متعانقة كونيا مع من أصبحوا خارج أسوار الوطن بسبب الكوارث التي هجّرت معها كل الأشياء الجميلة عبر قناطر ميناء اللاذقية . لنقرأ منولوجها المضمخ بالنزيف :
لا لا .. لن أقبل
إنه ليس اليوم العالمي للقُبل
فهناك قبلة فقدت ذاكرتها
وصارت نزيفا ، و قبلةٌ ..
نسيها شابٌّ عَجولٌ ، على مكسر الميناء
…..
أنا الحمقاء ، لم أزل
حافيةً ، أجمع قبلاً محطّمةً
يرميها المدّ ، وأطويها كرسائلَ معطّرة
في أوربا نستطيعُ أنْ نرى القُبلَ الطّويلة ، و العناقَ الشّديد و الضمّ الخفيفَ ،إنّهم يفعلونها أكثرَ حميميّة في الشّوارعِ المكتظّة بعابري السّبيل أو الحاسدين ، مثل شعوبنا. أما التقبيل في اليوم العالمي وفي أعياد الميلاد تستطيع أن ترى القبل من الغاديات والسابلات في الشوارع الدنماركية ، هنّ من يبادرن في إعطائك قبلة في الجبين ، أنت وحظك في كيفية الحصول على قبلةٍ وأين يكون موقعها ياترى من تقاسيم وجهك في ذلك اليوم العالمي للتقبيل والعناق .
أما المرأة في سوريا وفي اللاذقية التي عاشها أبو العلاء المعري وخلّدها في أعظم بيت له ( في اللاذقيةَ ضجةُّ بين أحمد والمسيح /فذا بناقوسٍ يدق وذا بمأذنةٍ يصيح / كلّ يعظمُ دينه / ليتَ شعري ماالصحيح) ، المرأة تلملم القبلات القادمة مع أمواج البحر من الذين غادروا البلاد قسراً نتيجة الظروف الإستثنائية ، التي أجبرتهم على ترك البلاد ومافيها من أمهاتٍ ثكِلات . حتى تصل الشاعرة في نفس النص للناستولوجيا البالغة في وصف الحال الشائك وما من حلولٍ تلوح في الأفق القريب :
في بقج الحنين ، ناسيةً
أنّ لي ، أنا الأخرى شفتين
يا حبيبي قل لهم ، ألم يكن لي
قَبل هذي المعمعة شفتين ؟!
رماح هنا إقتربت من المدرسة الرومانسية التي برع بها الفرنسي الشهير ( فكتور هيجو) ، المدرسة التي يتجه بها الطريق السحري نحو الداخل ونحو ماتقوله الشفاه السارحة في الخيال المترف ، وماذا يقولهُ مُحيطُ الهوى السكرانِ بالنبيذِ الشيرازيّ ، آآآآه ..آآه لوكان لي ثغراً .
ويستمر الكشف مع ألوان الشفاه المخضلة أو على طبيعتها كما خلقتها آلهةُ فينوس أو أفروديت لتنزل الى السواعد المترفة وأكمامها الطويلة والقصيرة و حسب الوصف الفواكهي في الثيمة أدناه :
على بلوزتي الليمونيّةِ
نصفَ الكُمّ ، يتشيطن نسيمٌ
يسري كدعسوقةٍ لطيفةٍ
على ساعدي ، و ينطُّ ، يدغدغني
أضحكُ ، فتغلُّ عصافيرٌ بحلمي
و تشعشع بالتّتالي ، مصابيحَ عشقٍ خجولة !
،
الأكماملس ، less حين تدخل على الكلمة تتحول من الإثبات الى النفي ولذلك نرى نصف الكم ، أوالأكماملس أعطى للنسيم حرية التداعب والمساحة الواسعة لرذاذ عطراللاكوست أو الشادو ديور على ساعدٍ يزهو مفتخراُ بالجمال حتى اذا وجد نفسه في باص المدينة تحفزت حاسة الشميم فتلتفت الرقاب إجبارا وسحرا وعسكرة لأداء التحية لأميرةٍ مرقت ، فيتوجب الصمت في سوريا الصامدة اليوم وما علينا سوى أن نلوّح لأي إمرأة بالتهاني والتحايا رغم ماتمر به من محنٍ حتى تتحول من ثقل أوزارها الى ذئبة متوحشة رغما عنها نتيجة الظرف المارد الذي يسيطر على مفاصله النصب والإحتيال كما في هذا البوح المزيج من عواء الذئب وصوت ألأغاني :
رجل
كلما آوته برتقالة
صار حطباً !
امرأةٌ
كلما ناولوها دمعة
صارت ذئبة ، وكسرت النوافذ!
صديقٌ
كلما لوّحتُ له بأغنيةٍ
انكسرت بنا رقبة الطريق !
هذه الثيمة تجسدت في الرواية العظيمة ( الإحتقار) للإيطالي الشهيرالبرتومورافيا والتي مثلت في أكثر من فيلم جميل وكيف نرى بطلة الرواية( أميلي) في تحولها المفاجيء واحتقارها العظيم لزوجها وحبيبها ، ليس لشيء سوى أنه لم يفهم كيف يحب هذه المرأة التي قدمت له أيام زمان مضى وطَراً لايوصف من حميميةٍ وحب كبيرين .
أما في الشذرة الأخيرة أعلاه تدخلنا رماح الى تأريخ بأكمله عن المروءة والشهامة او الصداقة ، فهناك مثل صيني يقول (اذا لم تستطع ان تصنع لك صديقا فلا تجعل لك اعداء ) . عبد الله ابن المقفع الشهير بكتابه (كليلة ودمنة) كان يقول ( أدافع عن صديقي بسيفي ومالي) لكن الأوغاد أحرقوا جثته وعملوا منها (كفتة) لأنه كان فيلسوفا لادينيا وعدواً للخليفة والسلطة والجاه ، لأنه كان صادقا مع صديقه الخليفة ولمجرد إختلاف في وجهات النظر حصل الذي حصل ورماه الخليفة الطاغية في التنور وأحرق جسده الطاهر بعد ان مثّل به وقطع لحمه حتى أصبح مثالا للمروءة الهادرة في الأبدية ونيل الشهادة على أمرٍ يستحق . وهناك من يقول في باب الصداقة ( الصداقة مظلة عيبها انها تنقلب في الطقس السيء .. بيير فيرن ) مثلما الرفقة في هذا الزمن الرديء التي ترى بها صديقك في منتصف الطريق الذي لم يكتمل بعد ويقول لك باي باي .
يتبـــع في الجـــــزء الثانــــي
هاتف بشبوش/شاعروناقدعراقي