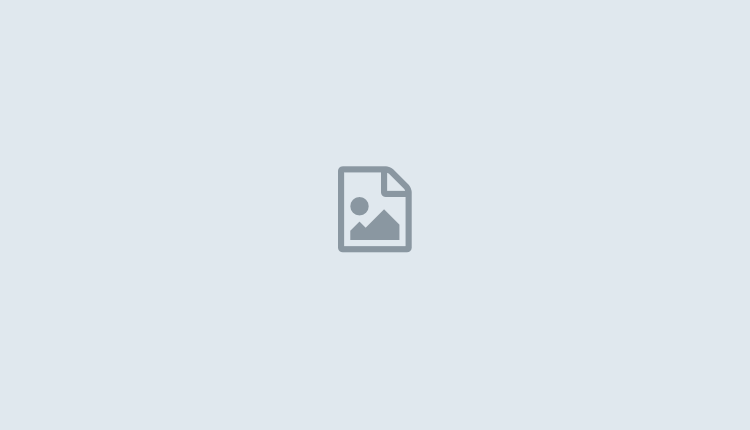تراتيل في زمن الخوف
بدور زكي محمد
كاتبة عراقية
في هدأة الليل، جلست وحيدة تستمع لنغمة بعيدة الغور في عمر شبابها، صوت يحاكي اشتياقها لابنتها وأبنيها، لمن أجلتهم الحوادث وعسف السنين فتوطنوا في ديار غريبة. ما الذي حمله صوت أسمهان من وجع وخوف، فصارت تردد بما يشبه الدعاء” لا ضَرب المقدورُ أحبابنا، ولا أعادينا بهذا الحُسام”، هواجس أطالت سهرها، وردّتها لساحة أحزانها، يوم أسدلت ستار اليأس، فما عاد الزوج من سجنه، ولا بقي الشقيق الذي كان يواسي وحدتها، حتى جسده الضامر تناثر أجزاءً على الطريق، إلى جانب صبيةً خرجوا للتو من مدرستهم، وعابرين يتلقطون رزقهم. ثقيلة هي الحياة حين لا تغادرنا وحشة الذكريات. أعوامٌ تمضي تنخر في جدار الصبر، وهمٌّ جديد تجاوز كل هموم العيش، ضاق به صدر نبيهة، المعلمة المتقاعدة، وهي تدعو بالسلامة لابنتها البعيدة في الطرف الغربي من العالم، تذكرتها كم كانت سعيدة وهي تحزم أمتعتها وتستعد للسفر إلى أميركا، تسابقها آمالها في الحرية، فبعد وفاة والدها وقعت وداد في قيد عمها الأكبر، وكاد أن يجبرها على الزواج من ابنه، لولا أنها استعجلت أوراق سفرها بمساعدة زميل لها في العمل. أين هي الآن من حلمها، طريحة الفراش منذ أكثر من شهر، وحيدة في عزلة المرض اللئيم، بئس الأسماء كوفيد التاسع عشر. كيف للأم أن تنام وابنتها تواصل الأنين، وتضطرب أنفاسها لعلّة قديمة أصابتها في طفولتها، وأخرّت شفاءها، من يحنُّ عليها في تلك المدينة الكبيرة، من يسقيها شربة ماء حين يجفّ ريقها، “أكاد أسمع سعالها، وحشرجات أنفاسها، آه يا بنيتي ليتني استطيع السفر إليك، عامان مضيا وهم يؤجلون حتى حلّ الوباء، ولا أدري هل كانوا خائفين مني وكأن بي داء من الإرهاب الذي صنعوه… ” امرأة عبرت السبعين بخمسٍ، هدّها التعب ولوعة الفقدان والفراق، ماذا عساها ستضُّر امبراطورية على رأسها مخبول معجب بنفسه؟
” “ربي احفظها من كل شر، وعجِّل في شفائها ويسِّر لقاءنا، وإن مسَّني عارض المرض فلن أبالي، كفاني ما عشت، ويكفيني أن أكون عوناً لها”
تفيق نبيهة من هول ما يؤرقها فتمسك بهاتفها الذي ظل يرُّن وهي غافلة عنه، هذا ابنها سليم يطمئنها على حاله، هو وزوجته يعملان من بيتهما في لندن، ولكن وماذا عن حفيدها، المدارس هناك لم تغلق بعد ” دخيلك إبني دير بالك عليه”، يطلق الإبن زفرة ساخرة، ويقول: لا تقلقي حصلت له من طبيبه العراقي على إجازة مرضية، ومازال العباقرة من مسؤولينا يبحثون إمكانية غلق المدارس، بينما تفتَّق ذهن رئيس وزرائنا الكسول، ذو الشعر النافر، فقال: أن المدارس آمنة!! ” آه يا ولدي، كم أتوجع لفراقكم، أين أخاك محسن؟ منذ شهر لم أسمع صوته” يحار سليم بماذا يجيبها فيقول: ” تعلمين يا أمّي أنه طبيب وليس لديه وقت، صحته على ما يرام ويحتاط جيداً، لا تخافي”. تطلق آهة حرّى ويتكسر صوتها ” كيف لا أخاف وهو بعين الخطر، دعه يكلمني، أرجوك “. وعدها وأغلق الهاتف لأنه لم يستطع تحمل دموعها، وهو خائف على أخيه مثلها. طائرالخوف يفرد جناحيه على رؤوس الجميع، لكن أكثر صوره غرابة ما رآه سليم على وجه جاره المُسِّن، حين طرق بابه ليطمئن عليه، فإذا به يطلُّ عليه من خلف النافذة، بعينين جاحظتين، غاضباً مرعوباً كمن يخاف من عدو يوشك أن يقتحم داره، لا أدري لماذا، هل هو التشبث بالحياة، أم داء الوحدة الذي يجعل الإنسان منطوياً على ذاته، يرتاب من كل بادرة. النفوس تتداعى من هول الوباء وقوافل الراحلين، وقليل من الناس ينجيهم تفاؤلهم، بينما كثرة تحتمي بغبائها، ولامبالاتها، والأدهى من يزعمون بأن عاصفة الموت وهمٌ، وليس ذلك عجيب، فمنهم من أنكر كروية الأرض!! ألسنا في زمن الحروب وانحدار الثقافة؟!
يعود الليل حزيناً، ويلقي على الأم أسئلة لا جواب عليها، “ماذا لو نزلت لعنة الوباء على ولدي الأصغر، كم من المرضى يعالجهم كل يوم، لماذا لا يستقيل ويعيش معي، فبغداد مع كل ما تشكو من هموم وفوضى أفضل حالاً مما يجري في بلدان التقدم والرفاه، ولكن ألا يعني هذا هروباً، ولا أحسب أن محسن جباناً “. وبين هذه الخواطر، وكما لو كانت رؤيا، استعادت نبيهة مشهداً رهيباً، يوم خاطرت بحياتها وأخفت شاباً هارباً من الخدمة العسكرية، الحرب كانت على أوجها، والهاربون توشم جباههم، وتُقطع آذانهم، والويل لمن يأويهم. هي لم تعش لنفسها فقط، وكانت تواقةً لمساعدة الغير، فكيف تريد لإبنها أن يتنكر لبلد آواه ومنحه تعليماً عالياً. تفكرت ورأت في الصبر مفتاحاً لأمان النفس، فالقلق غير مجدٍ، وإلا ستسقط في شباك اللعين؛ ابن التاسع عشر، ليس منه بل من الخوف. ما العمل، لابد أن تشغل يومها قبل أن يمتلأ رأسها بالهواجس. صعُب عليها المنام وراحت تتفقد رفيقها الدائم؛ هاتفها، تستمع إلى تسجيلات أحبابها البعيدين، وتذرف الدموع، بقيت كذلك حتى سرقها النوم. صحت على صوت الأذان من جامع قريب، ويبدو أن المؤذن أصيب بنزلة برد نالت من صوته الجَهْوَري، فلم يُفزعها كعادته. قامت لتصلي وتبدأ يوماً جديداً لا يشبه أيامها، فلابد أن يكون لحياتها معنى، لا أن تبقى تنوح على أولادها في غربتهم، وتتخيل مصائر مفجعة، لماذا لا يكون العكس، نفحة تفاؤل أصابتها فعاودها شعور قديم مشبع بالخير، ألهمها بأن تبادر بتوزيع كل ما فاض عن حاجتها على من يستحقون، الناس في ضائقة والحياة تزداد صعوبة، وما دام أولادها لا يبخلون عليها فلن تفتقر. هكذا استعادت روحها الطيبة، وخلعت رداء اليأس والشكوى. كثير من الأمل بدأ يساورها في ان تسافر إلى نيويورك وتلقى ابنتها، سيذهب رئيس مهووس بالكراهية، ويأتي آخر معتدل، ستكتب له رسالة وترجوه أن يمنحها تأشيرة وتقطع له وعداً بالعودة، ضحكت من الفكرة وقامت لتجمع كل ما عندها وتبدأ مشوارها.