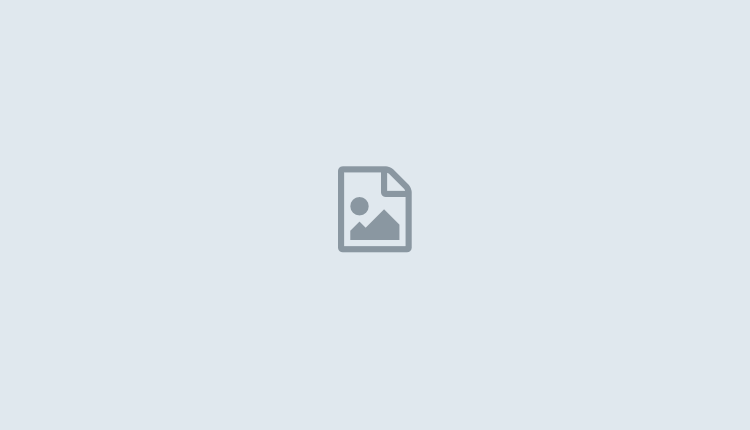جسار صالح المفتي
واجه العالم خلال الأشهر الأولى من عام 2020 جائحة انتشرت عبر العالم اصطلح على تسميتها بجائحة فيروس كورونا المستجد. أجبرت هذه الجائحة معظم دول العالم الانغلاق على نفسها، ومن ذلك تطبيق الحجر المنزلي وحظر الانتقال وإيقاف مظاهر وأنشطة نشأنا عليها، مما خلق أزمات حقيقية في مختلف جوانب الحياة حولنا. الأزمة تسببت في تقليل أعداد العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وإلى اغلاق المدارس والجامعات والمحال التجارية والمقاهي ومعظم مناحي العيش التي كنا نعتقد أنها أشكالاً حتمية للحياة الطبيعية. نتيجة لذلك، أُعيد توجيه علاقة المواطنين في كل الدول بحكوماتهم، وبالعالم الخارجي، بل وحتى مع بعضهم البعض، لذلك قام العديد من المراقبين بتوقع تغييرات سوف تظهر الى السطح في الأشهر والسنوات القادمة. قد يبدو بعض تلك التوقعات غير مألوف أو مقلق، لكنها في مجملها تشير الي أن العالم سيبدو مختلفًا بشكل كبير عما اعتدنا أن نراه ونعيشه، على الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لذلك نستعرض هنا أهم تلك التوقعات، نتناولها بشيء من الدراسة والتحليل بشكل علمي، حتى يتمكن أبناء الوطن ومتخذي القرار من بناء قرارات مناسبة تضمن استقرار وقوة وأمن شعوبنا ومنطقتنا العربية. ومن ذلك أنه على المستوى السياسي نجد أن الدلائل المبكرة تشير إلى تغييرات جوهرية حدثت بالفعل، مثل التراجع عن العولمة وتقوية حالة الدولة القومية، وإغلاق الحدود السياسية، حتى بين الدول التي سبق واعتادت على محوها فيما بينها، مثل دول الاتحاد الأوربي. كما تجلّى ذلك في منع السفر لمواطني الدول العربية، ومنها دول الخليج العربي التي اعتاد مواطنوها وقاطنيها التنقل فيما بينها بالهوية الوطنية وليس جواز السفر، هذا بلا شك قطع أوصار التواصل المُعتاد بين الأهل والأقران من أبناء المنطقة، بل ظهرت لنا حالات من قطع التواصل بين المدن في الدولة الواحدة. إن الخبراء يرون أن أزمة بهذا الحجم يمكن أن تعيد ترتيب المجتمعات بطرق درامية -للأفضل أو للأسوأ- حسب ما سينبني مستقبلاً على أساليب التعامل مع المخاطر والمتغيرات التي سوف تخلقها هذه الأزمة. في هذا المقال نستعرض بعض التأثيرات المتوقعة للأزمة التي نشأن عن تفشي فيروس كرونا المستجد على الفرد والمجتمع والدولة، وذلك بعد دراسة تلك الآراء والتوقعات.
أولاً- تأثير الأزمة على السلوك البشري الفردي
إن خطر العدوى وما ترتب عليه من أمور مثل العزل المنزلي أدى إلى تغيير في استجاباتنا النفسية للتفاعلات العادية بين الأفراد. هذا دفعنا إلى التصرف بطرق غير معتادة بين أبناء المجتمع الواحد بل الأسرة الواحدة. فقبل الجائحة كان نادرًا ما يأتي على تفكيرنا خطر انتقال الأمراض نتيجة للتواصل الاجتماعي المباشر، لكن بعد انتشار الوباء، ونتيجة للتغطية الإعلامية اليومية والمستمرة من حصيلة للقتلى من هذا الوباء، وما امتلأت به منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالإحصاءات المخيفة أو النصائح العملية أو الدعابة أحياناً، أصبح كثير من الأفراد – لا بل عمومهم – لا يفكر الا فيما سيترتب عليه انتشار هذا الوباء على سلامتهم الشخصية ومستقبل حياة أبناءهم. هذا الموضوع أضحى يحتل مساحة كبيرة من قلق لجميع البشر ويضعهم تحت ضغط شديد من التفكير. وهناك الكثير من المحللين(1) ذكروا أن الضغط المستمر من الإعلام يمكن أن يؤدي إلى زيادة حالات الشعور بالقلق، والي آثار فورية على صحتنا العقلية، فالشعور المستمر بالتهديد قد يكون له آثار أكثر خبثًا على حالة الأفراد النفسية وسلوكهم البشري. حتى أن البعض ذهب الى أن هذه الأزمة يمكن ان تجعل من بعض الأشخاص خطرين، لأن فقدان الشعور بالأمان يمكن ان يخلق اشخاص يرون ان الانتحار او القتل او التخريب هي سُبُل لتحقيق الأمان المفقود(2). وقال بعض الباحثين انه من تبعات هذه الجائحة أن جميع من تابعوا الأخبار العلمية التي انتشرت مطلع هذا العام تكوّن لديهم هاجس واقتناع بأن لمس الأشياء أو التواجد بالقرب من أشخاص آخرين أو تنفس الهواء في مكان مغلق يمكن أن يكون أمرًا محفوفًا بالمخاطر، هذا جعلهم يستبدلون راحة التواجد مع الآخرين براحة أكبر عند غيابهم، خاصةً أولئك الذين ليسوا من القاطنين معهم أو القربين منهم، ولسوء الحظ، هذا يجعل من أولئك الذين ليس لديهم علاقات ومعارف مقرّبة أكثر حرمانًا. ولا شك أن المشاكل النفسية سوف تتفاقم بشكل أكبر عند الشباب ممن فقدوا وظائفهم بسبب الاضرار الاقتصادية التي نتجت من الخوف من تفشي الوباء. ولرُبما سيُصاب الكثير منهم بأمراض نفسية إذا لم تتم مساعدتهم للخروج من هذا المأزق، ومن ذلك مساعدتهم بتوفير فرص عمل لهم أو دعمهم لتأسيس مشروع يُشغلهم ويُخرجهم من هذه الحالة. كما سيعاني آخرون من ضعف التواصل مع الأحبّاء، ورغم أن التواصل عبر الإنترنت كان غير مرغوبٌ فيه اجتماعياً قبل الوباء لكونه يؤدّي لخلق مسافات بين أفراد المجتمع، إلا أنه وبعد تفشي الوباء ومع حظر التجوّل والعزل المنزلي ارتفعت الحاجة اليه، فأصبح هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للتواصل مع الآخرين. ومن الامراض النفسية التي يمكن أن تظهر نتيجة الوباء مرض “رُهاب الجراثيم”، وهو نوع من اضطراب الوسواس القهري، وهذا يحدث للشخص الذي له تجربة مؤلمة مع العدوى، كوفاة أحد أحبته. ومن جانب آخر فإن انتشار الوباء يؤثر على الفرد بأن يجعله أكثر اهتمام بالجماعة وأقل فردية، وهذه حالة كنا نفتقدها كثيراً قبل الأزمة. ومن المكاسب الإيجابية أن جعلت الحكومات تضخ استثمارات كبيرة في المنافع العامة خاصة ما له علاقة بالجوانب الصحية والأمنية
ثانياً- تأثير الأزمة على المجتمع
إن استفحال الوباء وزيادة الضغط الإعلامي والصحي على مجموع الأفراد في المجتمع يمكن أن يتسبب في خلق أزمة اجتماعية بسبب عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين أفراد المجتمع. فقبل الأزمة ساهم الانفتاح على التعليم في اتساع الطبقة المتوسطة من ذوي الدخل المحدود والتي نشأت نتيجة طبيعية لتكافؤ فرص التعليم، ذلك أتاح لقطاع واسع من أبناء المجتمع أن وفرت فرص عمل جيدة في المجالات المهنية، فكان منهم المعلمين والمهندسين والأطباء، وحصل الكثير منهم على فرص أتاحت لهم تحقيق معدلات عالية من الدخل، والعيش في منازل مناسبة، واستخدام الاتصالات الحديثة والإنترنت والذي مكنهم من العمل عن بُعد، مما أتاح لهم حتى خلال الأزمة الحصول على دخل مناسب يستطيعون عن طريقه كسب عيش كريم والحصول على احتياجاتهم. إلا أنه في المقابل فإنه وبسبب الأزمة عانى الكثيرين من فقدان الوظائف وزيادة الأعباء العائلية، لأنهم إما أقل قدرة على العمل من المنزل، أو لأنهم يعملون في قطاعات خدمية أو باليومية، تلك الوظائف الأكثر عُرضة للخطر من الاتصال بالفيروس التاجي، إنهم قطاع من المجتمع يفتقر الي فرصة العمل عن بُعد، وبالتالي فإنه في كثير من الحالات هناك احتمال أن لا يكسب أطفالهم تعليماً مكافئاً من المنزل، لأن آباءهم لن يتمكنوا من توفير احتياجاتهم من الأجهزة التعليمية، أو لافتقارهم الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة الذي يتيح التعليم الجيد عن بُعد، فضلاً عما قد يضطرون إليه من دفعهم مبكراً للعمل. هذا كله سوف يزيد من الفجوة بين الطبقات وفي عدم المساواة.
ومن جانب آخر فإنه سوف تزيد ثقة المجتمع بالعلم والعلماء بعد أن كانت تراجعت بشكل كبير بسبب أصحاب المصالح والشركات، بل وأحيانا كثيرة كانت تُشن حرب من أصحاب المصالح ضد كل ما يمكن أن يمس مصالحهم التي قد تكون حقائق يُراد لها الاندثار، ومثال ذلك عندما شن رجال صناعة النفط والغاز والتبغ حربًا دامت عقودًا ضد الحقيقة والعلم، في سعي لإثبات أن منتجاتهم لا تضر بالإنسان والبيئة(3). ولكن لأن تأثير الفيروس مختلف تماما عن اثبات علاقة صناعة النفط والتبغ بتغير المناخ، فكل المجتمعات رءوا تأثيرات فيروس التاجي على الفور وعرفوا أهمية البحث العلمي الحقيقي، وهذا ساهم في إعادة التعريف بالمفاهيم العلمية المبنية على الحقائق. ومن المكاسب الإيجابية أن تم استعادة الاحترام العام للخبرة في مجالات عديدة مثل الصحة العامة والأوبئة والتمريض ومهندسي الاتصالات والحاسوب وغيرهم. لقد أجبرت الجائحة المجتمع على العودة إلى قبول أهمية الخبرة والعلم، ليكون العلم والعلماء على مسافة متساوية من رجال الأمن والجيش في خدمة المجتمع.
ثالثاً- تأثير الأزمة على التعليم
لعل أكثر الجوانب التي تغيرت نتيجة لهذه الجائحة هو تغير أسلوب التعليم في معظم أنحاء العالم(4). فمع انتشار الوباء اتخذت دول كثيرة إجراءات سريعة وحاسمة للتخفيف من تطور الجائحة، وكان منها توقف الحضور الى المدارس والجامعات. وفي 13 مارس، قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أكثر من 421 مليون طفل قد تأثروا بسبب الإغلاق في 39 دولة. وقد نُقِل ملايين الطلاب إلى حالات “التعليم المنزلي” التي يظن البعض أنها مؤقتة. وعلى الرغم من أنه من المؤكد أن هذه التغييرات قد سببت درجة كبيرة من الإزعاج والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور في بداية الأمر، إلا أنها دفعت إلى أشكال جديدة من الابتكار التعليمي. وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه الحكم على كيفية تأثير أزمة انتشار وباء كورونا المستجد على أنظمة التعليم، إلا أن هناك إشارات إلى أن الأزمة سيكون لها تأثير دائم على مسار التعليم ورقمنته. إننا نعتقد أنه سيكون من المُستبعد العودة الي أسلوب التعليم المُعتاد قبل الجائحة، حيث نجد العديد من العائلات الآن تفضل التعليم المنزلي الكامل أو الجزئي أو الواجبات المنزلية عبر الإنترنت. لقد حُدّدت ثلاث اتجاهات يمكن أن تصف شكل التحولات المستقبلية الناتجة من انتشار الوباء على التعليم، هذه الاتجاهات هي:
· إنتاج أفكار جديدة وابتكارات مفاجئة: كان الميدان التعليمي قد عانى حالة من بطء وتيرة التغيير في المؤسسات الأكاديمية نتيجة مناهج التدريس القائمة على المحاضرات منذ قرون، والتحيُّزات المؤسسية الراسخة، والفصول الدراسية المُكتظة والتي عفا عليها الزمن، كل ذلك كان يقلل من كفاءة وجودة التعليم. ولكن انتشار الوباء ظَهَر محفزًا اجباريا للمؤسسات التعليمية للبحث عن حلول جديدة في فترة زمنية قصيرة للتعامل مع مواجهة انتشار الفيروس بحتمية منع الاتصال المباشر بين الطلاب والمعلمين وبعضهم البعض، وقد كانت البداية بالتعلم في المنزل عبر تطبيقات تفاعلية عبر شبكة الانترنت. فمثلا في الصين، حصل 120 مليون صيني على مواد تعليمية من خلال البث التلفزيوني المباشر. وقامت دول أخرى ومنها دولة الامارات التي تفوقت في استخدام برامج Microsoft Teams، بينما تم تنفيذ حلول أخرى أبسط – ليست أقل إبداعًا – حول العالم، فمثلا في إحدى المدارس النيجيرية، تم تعزيز أدوات التعلم غير المتزامنة عبر الإنترنت مثل مواد القراءة عبر Google Classroom، كل هذا دفع الطلاب إلى تعلم مهارات رقمية جديدة. ومع زيادة انتشار تقنية 5G في دول مثل الصين والولايات المتحدة واليابان، وجدنا الحكومات ومقدمي الحلول يتبنون مفهوم “التعلم في أي مكان وفي أي وقت”. هذا في مجموعه سوف يجعل الهيئات التعليمية تستبدل التعليم التقليدي بطرق تعليمية جديدة، وتنتقل من البث المباشر إلى استخدام تقنيات مثل الهولوجرام والواقع الافتراضي والواقع المعزز بحيث يصبح التعليم أكثر كفاءة وأكثر جاذبية واستمرارية.
· ازدياد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم: إن الحاجة لبدائل وحلول سريعة دفع بالهيئات التعليمية الى تكوين شراكات مع القطاع الخاص، وذلك لتأسيس أنماط جديدة من التواصل بين المعلمين والطلبة في إنقاذ للعام الدراسي ودعم العملية التعليمية، فنشأت شراكات بين الحكومات والناشرين والمؤسسات العلمية والمعلمين ومقدمي التكنولوجيا ومشغلي شبكات الاتصالات، صب كل ذلك في منصات رقمية كحل مؤقت للأزمة. لقد أصبح من الواضح أن الابتكارات التعليمية حظيت باهتمام تجاوز المشروع الاجتماعي النموذجي الذي اعتادت الحكومات على تمويله، وهنا نجد ثمار واضحة للاستثمار الكبير الذي أسس له القطاع الخاص في توسيع منتجاته من خلال تقديم أشكال مختلفة من البرامج والبدائل لتطوير التعليم قبل أزمة تفشي وباء الكورونا، ومن ذلك ما قامت به شركات كبرى مثل ميكروسوفت وجوجل في الولايات المتحدة وسامسونج في كوريا وبينج وعلي بابا وتنسنت في الصين، فكل هذه الشركات كانت تستهدف التحول الرقمي في التعليم والوصول به الي أكبر قدر من الطلاب حتى يكون هؤلاء الطلاب مستهلكين جديدين لمنتجاتهم. لقد كانت معظم هذه المبادرات محدودة النطاق ومعزولة نسبيًا، لكن تفشي الوباء مهد الطريق لتشكيل تحالفات واسعة مع هذه الشركات لتحقيق أغراض كلا الطرفين مما نتج عنه كما ذكرنا التأسيس لشكل تعليمي جديد ومشترك.
· اتساع الفجوة الرقمية: لقد اتخذت معظم المدارس في المناطق المتأثرة حلولًا مؤقتة باستخدام شبكة الانترنت لمواصلة التدريس، ولكن اتضح أن نجاح هذه الحلول وجودة التعلم بهذا الأسلوب الجديد يتأثر بشكل كبير بمستوى وجودة الوصول الرقمي. فإذا علمنا أن حوالي 60٪ فقط من سكان العالم يستخدمون الإنترنت، فهذا معناه أن هناك عدد ليس بالقليل من الدارسين لن يحصلوا على التعليم المناسب او سوف يكون تعليمهم أقل كفاءة. كما أنه من الواضح أن المشكلة ستكون أكبر عُمقاً في الدول محدودة الإمكانات أو الأسر قليلة الموارد والتي لا تتمكن من توفير الأجهزة الرقمية للطلاب. لذلك إذا لم تنخفض تكاليف وجودة الوصول الي الانترنت في كل بلدان العالم، أو إن لم تنخفض أسعار الأجهزة الرقمية في البلدان الفقيرة، فسوف يخسر الكثير من الأطفال حق التعليم، وسوف تتفاقم الفجوة في جودة التعليم، وبالتالي ستزداد الفجوة في المساواة الاجتماعية والاقتصادية. وهذه الفجوة سوف تزيد أكثر إذا تم اعتماد التقنيات الحديثة في التعليم.
رابعاً- تأثير الأزمة على التكنولوجيا
إن انتشار الجائحة والاعتماد المتزايد على الشبكة العنكبوتية سيُخفض العديد من التحفظات والحواجز التنظيمية التي كانت تحول دون نقل المزيد من البيانات عن حياتنا عبر الإنترنت، بالطبع لن يصبح كل شيء في حياتنا افتراضياً، لكن الاتجاه العام يُنبئ بأن نسبة كبيرة منه ستكون(5). وعلى سبيل المثال، نجد قبول واضح من أولئك الذين كانوا قبل انتشار الجائحة ممتنعين عن استيعاب أدوات الإنترنت المفيدة خاصة من الأجيال التي سبقت انتشار التكنولوجيا، هؤلاء معظمهم يشكلون العمق البيروقراطي في منطقتنا العربية. إن المقاومة -التي يقودها من يخافون من استخدام التكنولوجيا- قد جرفتها الضرورة بعد ازمة انتشار الوباء. حتى أننا نشهد تزايد كبير في استخدام التطبيقات التكنولوجية، ومنها استخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه في الصين لإدارة الحشود والمراقبة، واستخدام كوريا الجنوبية لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار لفرض الحجر الصحي ولتتبع الأفراد الذين من المحتمل أن يكونوا مصابين. كما قدمت التكنولوجيا الكثير من أشكال الترفيه الرقمي أثناء الحظر، فضلاً عن التواصل بالاتصالات المسموعة والمرئية، والتَسوُّق وتسليم السلع والطعام عند الطلب للمنازل. هذا التمدد المتزايد للتجهيزات والتطبيقات التكنولوجية في الحياة العامة والخاصة للأفراد والمجتمعات يعززه تقدم كبير في القدرات التي تقدمها الابتكارات العلمية والتكنولوجية، والتي بدورها ناتج طبيعي لتعزيز البحث العلمي والتطوير والابتكار. والأمثلة كثيرة على القدرات التكنولوجية التي تم تسخيرها في المجالات الحياتية، نذكر منها ما تم استخدامه بالفعل مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والذي تم استخدامه كثيراً في مجال التنبؤ بحالات الانتشار، حيث يمكن لشبكة عالمية من الذكاء الاصطناعي أن تعمل في تحليل البيانات الضخمة من حالات الإصابة بطريقة شبكية للتنبؤ بمواقع ومدى انتشار الفيروسات وكيفية التعامل مع الواقع وتقديم حلول نمطية غير مرئية، وفي مجال الروبوتات فإنه أمكن تطوير نماذج كثيرة، منها ما تم استخدامها لخدمة المرضى المصابين وفي غرف الحجر لتقليص الاتصال البشري، وقد ظهرت مقاطع فيديو لروبوتات تقدم الطعام والأدوية للمرضى في ووهان في الصين.
كما أن من القدرات التكنولوجية ما يعد بإمكانات كبيرة يمكن تسخيرها وتطويرها لتقديم خدمات فريدة في مجال مكافحة الوباء، ومنها ما سيزداد استخدامه بسبب انتشار الوباء، نذكر منها: المصانع المؤتمتة والتي تباشر أعمال الإنتاج كبديل عن العاملين البشر الذين فرضت الجائحة الحجر على تحركاتهم، ومنها السيارات ذاتية القيادة التي تقدم خدمات المواصلات البديلة وتجنب الحشود، ومنها في مجال تكنولوجيا المراقبة والتي تم زيادة دقتها باستخدام تطبيقات الدفع الالكتروني مثل Alipay وWeChat وفيها تم تثبيت برنامج لتتبع خطوات الأفراد الذين قد تظهر عليهم أعراض المرض وتحذير الأصحاء من الاقتراب من المناطق الموبوءة، كما أمكن استخدامها للتنبؤ بالمصابين المحتملين من أولئك الذين احتكوا بحاملي الفيروس. ونلاحظ أيضا تطور في مجال تكنولوجيا برامج المساعد الصوتي، ومنها “أليكسا” التي تعمل كمساعد صوتي على الهواتف المتحركة، فتم تطويرها لتقوم بتحليل صوتي وللتنفس والسعال لتكتشف العدوى(6). ومن ذلك، أجهزة الاستشعار المدمجة في الملابس والقابلة للارتداء، والتي يمكن أن تعمل على تذكير الشخص بعدم لمس وجهه وتحليل نظافة اليدين والحالة الصحية لمرتديها. ولعل أحد أهم المجالات التي نتوقع تطورها هو نموذج التطبيب عن بعد، مما يتيح للمرضي البقاء في أماكن إقامتهم والتواصل مع الطبيب المعالج بشكل مباشر ومستمر، هذا من شأنه أن يحد من تنقل حاملي الفيروس في وسائل النقل العام، ويبعدهم عن غرفة انتظار المرضى في المستشفيات، والأهم من ذلك، أن ذلك سيقلل احتكاكهم بأصحاب الحالات الحرجة.
خامساً- تأثير الأزمة على الاقتصاد
قد يكون من الصعب حالياً التنبؤ بمدى تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، لكن يمكن الإشارة الي عدة عوامل ذات علاقة تأثرت بانتشار الجائحة، فمثلا يظهر أن صدمة الوباء جعلت من المجتمع يقبل التعديل على الثقافة الاستهلاكية، وذلك للحفاظ على الموارد التي يبدو أنها مهددة بظروف الحضر. خاصة وأن بعض الحكومات والكثير من الشركات قد استغلت الموقف لصالح تخفيض رواتب العاملين وتعديل أنظمة المكافآت. ولعل من أهم العوامل التي تأثرت بالجائحة سلاسل التوريد، فبالرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن الفيروس التاجي ينتقل من خلال السلع، إلا أن الكثير من الدول انتقلت الي سلاسل التوريد المحلية، وذلك بسبب القيود الكبيرة التي فرضتها تلك الدول على الحدود والمنافذ الجمركية، بما في ذلك إغلاق الموانئ والمطارات وتقييد الصادرات والواردات. إن التحول إلى سلسلة توريد محلية من شأنه أن يقلل الاعتماد على نظام الإمداد العالمي الذي ظهر عليه التصدّع. العوامل التي ذكرناها قد تقود العالم الى أزمة كساد كبير، حيث بدأ الامر يظهر بخسارات فادحة في قطاعات عديدة مثل شركات الطيران والسياحة وعلى محال التجزئة التجارية والمطاعم والفنادق وغيرها. هذا ونحن مازلنا في بداية صدمة الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية. وإن كانت معظم شركات الصناعات التكنولوجية المتقدمة تنتج أجهزتها في مصانعها التي في الجمهورية الشعبية الصينية فإنه من المُتوقّع أن يحدث ضرر كبير في قطاعات الصناعة. المرحلة المقبلة ستشهد انخفاض في انتقال رأس المال وسفر رجال الاعمال، خاصة وأنه يمكن انجاز كثير من الأعمال من خلال الاجتماعات واللقاءات والمناقشات الافتراضية عبر شبكة الانترنت، وقد وفر البريد الإلكتروني وغرف الاجتماعات الافتراضية بتطبيقات الاتصال الشبكي المتعددة بيئة سهلة وبتكلفة منخفضة، جاء هذا البديل كشكل مرغوب من أشكال التوفير في المصروفات والتكاليف، والتي يُتوقع أن تستمر حتى بعد الأزمة. إلا أن تفشي الفيروس وتخفيض التكاليف خلق ضغطًا مضاعفاً على الشركات من أجل الموازنة بين كفاءة العمل والعوائد والتي ستظهر بشكل موجات من تخفيض العمالة وبالتالي زيادة البطالة. ومع استمرار الازمة وحالة عدم اليقين الذي سببته، فإنه من المحتمل أن يتأثر قطاع التمويل، خاصة وأن التأثير الاقتصادي للفيروس التاجي على الاقتصاد العالمي غير واضح حتى الآن، لذلك قد يتردد المستثمرون في المخاطرة بالاستثمار في العديد من القطاعات المتضررة، وقد يحتفظون بأموالهم لتغطية العجز المُحتمل في استثماراتهم المتأثرة خلال هذه الفترة المضطربة. أما تحديات سوق الأسهم فان أرباح الربع الأول ستتأثر حتمًا، مما يترك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن مدى تأثير ذلك على أسعار الأسهم. وسيكون التحدي أمام المستثمرين على المدى القصير هو الحكم على ما إذا كانوا يتوقعون أن ترتفع الأسهم مرة أخرى، أو ما إذا كانت هذه هي المرحلة الأولى من الانهيار المدوّي. أضف الى ذلك، أنه من المرجح أن تتراجع مبيعات السلع الاستهلاكية والكماليات، فالمزيد من الناس يجدون بالخروج للسوق والتجوّل بين المتاجر أمراً محفوفاً بالمخاطر والاصابة بالفيروس. كل هذا من أسباب تفكك الأعمال الناتج عن الاضطرابات في السوق والتي ستواجهها الشركات المتعثرة وتضعها على حافة الهاوية. ولعل الأخطر من ذلك احتمال انهيار المنظومة الاقتصادية – والنظام الاجتماعي الداعم له، مما يحتم على الحكومات أن تتدخل لضمان استقراره وضخ الأموال في الاقتصاد المحلي وحماية ملايين العمال الذين سيفقدون وظائفهم أو انخفاض دخلهم منعاً من وقوع الدولة في حالة الكساد والفوضى.
سادساً- تأثير الأزمة على السياسة
من المحتمل أن تمتد آثار انتشار الفيروس التاجي الى انتفاضة سياسية داخل وخارج الدول، فمثلاً رأينا كيف أمكن تمرير واتخاذ إجراءات أمنية وسياسية في معظم الدول التي لجأت الى فرض الحجر بالاستعانة بالأجهزة الأمنية والعسكرية، تم ذلك بحملات إعلامية نشرت الشعور بالرعب من الوباء أقنعت المجتمع المستهدف أن الأمر عاجل وان هذا ضمن علميات الإنقاذ السريع لهم. يقول ستيفن م. والت(7) في مقال نشره خلال ذروة انتشار الوباء في أوروبا، وهو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد الأميركية، أن ” هذا الوباء سيقوي الدولة ويعزز القومية. ستتبنى الحكومات بجميع أنواعها إجراءات طارئة لإدارة الأزمة، وسيكره الكثيرون التخلي عن هذه السلطات الجديدة عند انتهاء الأزمة”. وأضاف “إن الأوبئة السابقة – بما في ذلك وباء الإنفلونزا (الاسبانية) في 1918-1919- لم تنهِ تنافس القوى العظمى ولم تبشر بعصر جديد من التعاون العالمي، وفيروس كورونا لن يفعل ذلك أيضاً”. وتابع: “سوف نشهد تراجع العولمة، حيث يتطلع المواطنون إلى الحكومات الوطنية لحمايتهم، بينما تسعى الدول والشركات للحد من نقاط الضعف في المستقبل”. وختم بالقول: “باختصار، سيخلق فيروس كورونا عالمًا أقل انفتاحاً وأقل ازدهاراً وأقل حرية”. هذه الجائحة سوف تحوّل لانتخابات الي التصويت الإلكتروني، فبينما يتصارع المسؤولون حول كيفية السماح بالتصويت الآمن في خضم وباء، فإن تبني تكنولوجيا أكثر تقدمًا – بما في ذلك التصويت الآمن والشفاف والفعال من حيث التكلفة من الأجهزة المحمولة – سوف يصبح أكثر احتمالية. وعلى المدى القريب، قد يقبل المُشرّعون بنموذج التصويت الهجين الذي يتكون من التصويت الإلكتروني وبطاقات الاقتراع الورقية معا. ولعل الشيء الإيجابي المُحتمل لتأثير انتشار وباء الكورونا على السياسة هو انخفاض الاستقطاب، يقول بيتر ت. كولمان أستاذ علم النفس بجامعة كولومبيا(8): “أن الصدمات غير العادية التي تجلبها جائحة مثل الفيروس التاجي لها القدرة على تحرير المجتمعات من تصاعد الاستقطاب السياسي والثقافي الذي وقعت فيه منذ ما يزيد عن 50 عاما، وعلى تغيير المسار نحو وطنية وتضامن أكثر”، ويقول إن هناك سببان للاعتقاد بأن هذا يمكن أن يحدث: السبب الاول “العدو المشترك”، حيث يتجاوز الناس عن خلافاتهم عندما يواجهون تهديدًا خارجيًا مشتركًا. فقد قدم لنا وباء كرونا المستجد عدوّاً هائلًا لن يميز بين عرق او لون وأصبح عدو واحد مشترك للكل، مهما كانت التوجهات والاعراق والجنسيات والأديان مختلفة. السبب الثاني هو “موجة الصدمة السياسية”، حيث أظهرت الدراسات أن الأنماط ذات العلاقات القوية والدائمة غالبًا ما تصبح أكثر عرضة للتغيير بعد أي صدمة قوية. وقد وجدت دراسة على 850 نزاعًا مستمرًا بين الدول حدثت بين 1816 و 1992 أن أكثر من 75% منها انتهت في غضون 10 سنوات من صدمة كبيرة حدثت لهم. وقد كانت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي نشرت مؤخرًا تقريراً حول “الاستقطاب والوباء”(9)، وفيه مجموعة من دراسات الحالة التي تبحث في عشر دول نشأت فيها صراعات لإلقاء الضوء على هذا الموضوع.
سابعاً- تأثير الأزمة على شكل وطرق عمل الحكومات
نتيجة للجائحة سوف تستعيد الحكومات أهميتها وسوف تزداد ثقة المجتمعات فيها، ولن تستمر الفكرة التي انشرت منذ فترة كبيرة بأن الحكومة هي “طرف آخر” وأن كل شيء حكومي سيئ. هذا الحدث أعطى دليلاً على أن وجود حكومة عاملة أمر بالغ الأهمية لمجتمع سليم. كما سنجد أن هذه الأزمة سوف تخلق ما يُطلق عليه فيدرالية المدن، فعندما ننظر إلى ما حدث خلال أشهر الأزمة، سنرى أن بعض المدن والمجتمعات – في نفس الدولة – تعاملت مع الأزمة بشكل أفضل من غيرها، وكان العنصر المشترك بين تلك المدن أن انضم فيها قادة المجتمع مع الحكومة والقطاع الخاص ليعملوا معًا بروح التضامن من أجل الصالح العام، هذا أعطي نوع من الفيدرالية الي تلك المدن. كما وجدنا أنه ظهر شكل متميز من الإصلاح داخل الحكومات، ووجدنا دور مهم وأساسي للخبراء والمختصين العلميين (وليس الموالين السياسيين) في جميع مفاصل اتخاذ القرار الصحي والأمني، لقد خلقت الأزمة حاجة عظيمة الى موجهات علمية تشترك في حماية صحة المجتمع والحفاظ على حرياته والإشراف على أمنه القومي، وظهر أن القرارات يجب أن تُتّخذ من خلال عملية سياسة مستنيرة ومبنية على الأدلة العلمية القائم على المعرفة الاجتماعية والمعرفة التاريخية والجيوسياسية، وليس على “الحقائق البديلة”، أو النفعية السياسية البحتة. كما، سنشهد عودة إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وإلى فهم أن التعاون مع الجميع أمر ضروري، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المشكلات العالمية مثل تغير المناخ والصحة العامة. إلا أن هذه الأزمة من جانب آخر عززت بعض المظاهر السيئة، فتَحتَ غطاء السيطرة على انتشار الفيروس التاجي اتخذت عدة حكومات تدابير استبدادية تهدف إلى تعزيز قبضتها على السلطة، إن الذعر الجماعي الذي نتج عن ارتفاع عدد الوفيات كان بمثابة “الصدمة” الجماعية المطلوبة التي تحتاجها الأنظمة الاستبدادية لاغتنام اللحظة ولتقويض أي مظهر للديمقراطية في مجتمعاتهم، وذلك كما ذكرت الكاتبة نعومي كلاين في كتابها “عقيدة الصدمة”(10). ولا يمكن إنكار أن الأزمة العالمية التي دعا إليها تفشي الوباء تُجسد في داخلها فرصة لتغيير أساسي لكل الأنظمة. وهذا مثلا ما قامت به الصين فقد تمكنت الدولة من تعويض الاستجابة المبكرة من خلال تعبئة بنيتها التحتية الضخمة والمعقدة للمراقبة لتنفيذ حملة الحظر باستخدام القوة. وهذا الأسلوب ورغم إنه مخالف لمبادئ الديموقراطية الا أنه نجح وجاء بنتائج إيجابية على الصحة العامة. هذا الأمر لم يقتصر على الصين فقط، فقد زحف تأثير كرونا السلطوي في كل مكان. فقد قامت سنغافورة بتسوية في نفس الاتجاه من خلال وضع تدابير استباقية مبكرة مثل فرقة عمل لمكافحة الفيروسات، والحجر الصحي في المستشفيات والمنازل، وحظر التجمعات الكبيرة. كما استخدمت تقنية تسمى “تتبع الاتصال”، وفيه تم بناء سجل حركة المصابين من خلال لقطات المراقبة والتوقيعات الرقمية التي خلفتها عمليات السحب بطاقة الصراف الآلي ومدفوعات بطاقة الائتمان، وكذلك من تطبيقات تتبع الهاتف الذكي. كما لجأ بعض دول الاتحاد الأوروبي الى نفس النهج، ومنها جمهورية المجر، والتي أقر برلمانها مشروع قانون يمنح رئيس الوزراء “فيكتور أوربان” الحق في الحكم بمرسوم إلى أجل غير مسمى، ومنحه حق إنشاء حالة الطوارئ دون مهلة زمنية، وكذلك تعليق البرلمان والانتخابات وتحديد وقت السجن لجرائم نشر “الأخبار المزيفة” أو الشائعات. وفي دول أخرى مثل إيطاليا والنمسا و”إسرائيل” استُغلت شبكات الاتصالات لاستخراج بيانات الموقع لتتبع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة، ولمراقبة ما إذا كان المواطنون يخالفون أوامر البقاء في مكانهم. كما استخدمت روسيا نظام كاميرات المراقبة بين مدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ والذي يحتوي على 170,000 كاميرا للتعرف على الوجوه والقبض على الأشخاص الذين ينتهكون الحجر الصحي والعزل الذاتي. ونشرت هونغ كونغ أساور إلكترونية لتتبع تحركات أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس. وفي تركمانستان لم يعد يُسمح لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة باستخدام كلمة “فيروس كورونا”، وقد تمت إزالتها من كتيبات المعلومات الصحية. وفي الهند جربت الدولة ختم الأشخاص الذين أصيبوا بالحبر الذي لا يُغسل لأسابيع، كما أصدرت الحكومة المركزية الهندية حكم من المحكمة العليا في البلاد يجبر جميع وسائل الإعلام على الحصول على موافقة مسبقة لطباعة أو نشر أو بث أي محتوى تلفزيوني حول وباء كرونا المستجد. كل ذلك يدل على أن الكثير من حكومات ارتأت ان انتشار الفيروس هو حالة طوارئ تتطلب وضع الخصوصية والحريات المدنية جانباً. ولعل الحقيقة الجلية التي كشف عنها الوباء القصور الكبير في أنظمة الرعاية الصحية في الكثير من الدول، وعلى رأسها الدول الكبرى قبل النامية، لذلك من المؤكد أن المواطنون سيطالبون بتغييرات كبيرة في طريقة عمل نظام الرعاية الصحية وربما الحكومة أيضًا بعد الأزمة.
وإن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد ورغم ما أصاب به العالم من صدمة وتخبط في التفاعل مع كل ما يحيط بالأفراد، إلا أنها بلا شك أتاحت استخداماً مرناً للتكنولوجيا الأكثر تعقيدًا. وقد ظهر للأزمة تأثيرات متباينة في مجالات متعددة ذكرناها في المقال، منها: الفرد والمجتمع والتعليم والاقتصاد والسياسة والحكومة، إلا أنها جاءتنا بفرص فريدة لمراجعة موقفنا من الحياة حولنا. لقد جمعت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الناس على هم وهدف مشترك، فأعادت تقوية الأواصر التي كادت أن تتهتك، ومنحتنا فرصة حقيقية لتقدير الحياة والبيئة والصحة العامة، وتقدير كثير من النعم التي غفلنا عن شُكرها وتعاملنا معها وكأنها نمط مُكتسب غير قابل للفقد. وهي – في المقابل – غيرت أمور عديدة لا يعُرف الي الان مدي عُمقها او حتى تأثيرها (سلباً أو إيجاباً) على الفرد والمجتمع والحكومة. هذه الأزمة أكدت أنه علينا بناء مرونة وافية في سلوكنا وأنظمتنا في ميادين العمل والتعليم وغيره من المصالح الخاصة والعامة، حيث أظهر الانتشار السريع للفيروس أهمية بناء القدرات المحلية والصمود في مواجهة التهديدات المختلفة من: الأمراض الوبائية إلى العنف المتطرف وانعدام الأمن المناخي. تمثل الجائحة أيضًا فرصة لتذكير أنفسنا بالمهارات التي يحتاجها الجيل القادم من أبناء المجتمع للتعامل بشكل أفضل مع ما لا يمكن التنبؤ بها، ومنها الوصول للقرار المستنير والحلول الإبداعية الناجعة، وربما قبل كل شيء القدرة على التكيف معها. صحيح أن جائحة فيروس كرونا تسببت بآلام ومعاناة هائلة، لكنها أجبرتنا على إعادة النظر في طريقة تفكيرنا وعلاقتنا بعقيدة مجتمعنا وهويتنا. ولعله على المدى الطويل، ستقودنا الى إعادة اكتشاف النسخة الأفضل من أنفسنا.