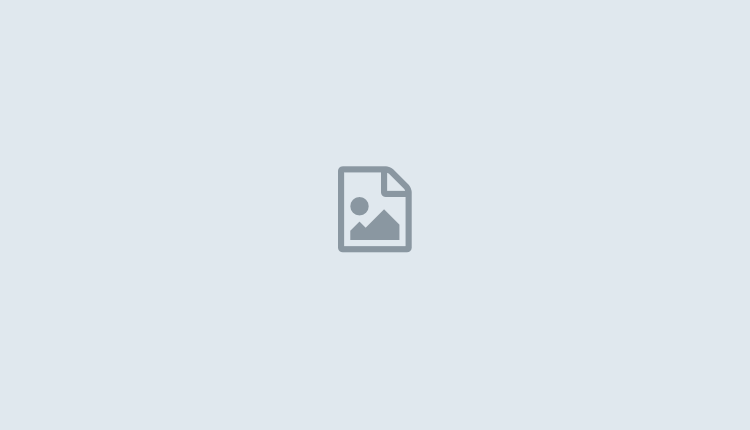الديمقراطية والدكتاتورية وظلامية المسؤولين والاتفاقات خلف الستار
د.سمير ناجي الجنابي
والديمقراطيّة هي مجموعة النظم التي تحقّق مبادئ الحرّيّة، والمساواة بين الناس بقدر ما يمكن أن يكون الإنسان حرّا، وهي المثل الأعلى لأنظمة الحكم، ومن أهمّ ثمارها حكومة قائمة على رغبة الشعب.
واليوم العالميّ للديمقراطيّة، وبحسب منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، يوفّر “فرصة لاستعراض حالة الديمقراطيّة في العالم. وتشكّل القيم المتعلّقة بالحرّيّة واحترام حقوق الإنسان، ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام؛ عناصر ضروريّة للديمقراطيّة”!
وتجربة الديمقراطيّة القائمة في العراق بعد العام 2004 تعدّ من التجارب المشوّهة لدرجة مُقزّزة، وأنّ العراقيّين لا يَدرون مَنْ هم الذين يقودون بلادهم.
يفترض في ظلّ النظام الديمقراطيّ أن يكون البرلمان هو السلطة الأبرز باعتباره يمثّل الشعب، لكنّ اليوم في العراق هنالك قوى دينيّة وسياسيّة أمام الستار وخلفه، هي التي تحرّك غالبيّة ملفّات البلاد السياسيّة والأمنيّة؟
هذه القوى الدينيّة والسياسيّة تُصدر تعليماتها المباشرة وغير المباشرة للسياسيّين، وبعد عدّة ساعات نجد بيانات الامتنان والمباركة والقبول لتلك التعليمات، وكأنّ مَنْ أصدروها هم الذين يقودون البلاد، وكأنّ البلاد خالية من البرلمان، وليس فيها أيّ حكومة!
هذا الوضع غير الصحيّ، يؤكّد أنّ الديمقراطيّة العراقيّة لا تَشبه الديمقراطيّات الأصيلة في معاقلها، وربّما نحن أمام نوع “مشوه” من الديمقراطيّة، هي أقرب إلى الدكتاتوريّة منها إلى الديمقراطيّة، وهي في غالبيّة تطبيقاتها دكتاتوريّة بثياب “ديمقراطيّة مُزركشة”، ولم يبق من مدلولها سوى ذلك الاسم المنمّق البرّاق!
الديمقراطيّة قبل أن تكون شكلا من أشكال الحكم، فإنّها نظريّة سياسيّة تدعو للتعايش السلميّ، واحترام الإنسان، وتقدير الرأي الآخر، وتقوم على جملة من المبادئ العامّة، منها الحرّيّة، والمساواة، وصيانة الحياة، والمُلكيّة، والفكر!
وتدعو الديمقراطيّة كذلك للقضاء على الحكم المُطلق والاستبداد بكلّ أشكاله، وللمساواة في الحقوق والواجبات، وإنهاء حالة الفوقيّة التي تَتَملّك نفوس بعض المسؤولين.
فهل هذه المبادئ والقيّم والعناوين المنضوية تحت فكرة الديمقراطيّة موجودة اليوم في المشهد “الديمقراطيّ السياسيّ العراقيّ”؟
لا شكّ في أنّ الإجابة الواضحة للكثيرين هي أنّ العراق اليوم يَسير في دروب “الدكتاتوريّة الجماعيّة”، المُشكَّلة من القوى الكبرى الحاكمة في الميادين السياسيّة والعسكريّة!
لقد أخفقت الديمقراطيّة العراقيّة في تحقيق غاياتها، بل، ربّما، يمكن الجزم بأنّه لا وجود أصلا لنظام حكم ديمقراطيّ حقيقي في العراق، وعلى نقيض من ذلك هنالك مؤسّسات دينيّة تتحكّم بقوّة في إدارة الدولة، والغريب هي تلك الاستجابات الرسميّة العاجلة لتطبيق تعليمات، أو أوامر المؤسّسات الدينيّة، وهذا لا يتّفق مع أبسط مبادئ الديمقراطيّة في أيّ مكان في العالم!
تنامي العيوب في الديمقراطيّة العراقيّة جعلها بحاجة إلى إعادة بناء من الأساس، وضرورة تطبيقها بشكلها الأصيل، وفي تربة صالحة خالية من السفّاحين والمتاجرين بالدين والوطن لتكون سبباً لنشر المحبّة والتعايش، وليس باباً لزراعة الكراهية والبغضاء، وربّما، لتنامي الإرهاب الطائفيّ بين الكثير من المواطنين!
التجربة الديمقراطيّة الهشّة في العراق، تؤكّد أنّ غالبيّة السياسيّين متّفقون مع رؤساء الحكومات، وربّما مع أطراف خارجيّة، لبقاء سياسة التخدير “الديمقراطيّ للجماهير”، التي يتمّ فيها التضحية ببعض المجرمين أو الفاسدين غير المواليين لهم بشكل كامل، وهذا سيؤدّي إلى إرضاء بعض المتظاهرين، وبقاء سطوة ذات الكتل الكبرى التي لا تقترب منها قوّة القانون بموجب هذا الاتفاق السرّيّ بينهم!
المضطهدون العراقيّون هم أنصار الديمقراطيّة، وهم الحالمون بغد مليء بالعدل والمساوة بين المواطنين، فهل سيرونه، أم ستبقى طموحاتهم مجرّد أحلام ورديّة بعيدة المنال؟
الحقيقة المُرّة التي يتهرّب منها غالبيّة ساسة العراق؛ هي أنّه لا يمكن بناء ديمقراطيّة نقيّة في ظلّ وجود مليشيات متوحّشة تعبث بسيادة الوطن وأمن المواطن، ولا ندري في نهاية المطاف لمنْ الغلبة؛ للديمقراطّية أم للمليشيات؟
و وصف الراحل أحمد حسن الزيّات للديمقراطيّة بأنّها “الصحّة التي انتهى إليها جسم الإنسانيّة العليل، أمّا الطغيان والبربريّة فهما نكسة المرض؛ والنكسة خلل عارض لا يلبث بحسن علاج الطبيب وصدق إيمان المريض أن يزول”!
فهل العراقيّون يسيرون اليوم في طريق الصحّة الفكريّة والحياتيّة، أم هم تائِهون في دوّامات السلاح المنفلت، والنزاعات الفرعيّة والهويات المتناثرة؟
التعنت والديمقراطية لا يلتقيان، فكلاهما مختلفان، الأول يميل إلى الإكراه والقوة والإملاء، فيما تذهب الديمقراطية إلى حرية الاختيار والرأي والانتخاب، ويبقى الشرط الوحيد هو التنافس بحرية تامة بين القوى السياسية (أحزاب وكتل وشخصيات سياسية)، وما تخرجه صناديق التنافس المنصف هو الذي يحدد الأحقية والأولوية في بلوغ دفّة الحكم.
التعنت يعني فيما يعنيه الإقصاء، والتشبث بالمنصب بالقوة، وفرض الرأي على الآخرين حتى لو كان غير مقنع أو ليس سليما، هذا النوع من النشاط السياسي لا وجود له مع الديمقراطية الراسخة، وإنما يمكن أن يتسلل إلى الميدان السياسي حين يتم الخروج على قواعد اللعبة الديمقراطية، وهو ما حدث في العراق عبر سنوات طويلة في سلسلة من الدورات الانتخابية التي تعرضت للتلاعب والتزوير واعتماد التعنت السياسي كبديل للمنهج الديمقراطي.
يقول باحث متخصص في السياسة عن الصراع والديمقراطية بأنهما مفردتان تقفان من حيث المعنى والفعل بالضد من بعضهما، ولا تلتقيان في ساحة السياسة إلا في حالة اختلال العمل السياسي، وانحرافه في مسارات قد لا تمت بصلة للديمقراطية بمفهومها المتَّفق عليه، فالمعروف أو المتوقَّع أينما توجد الديمقراطية على نحو صحيح ينتفي الصراع كمصدر تقاتل واحتراب بين السياسيين، أو بين الجماعات الساعية لبلوغ دفة السلطة، ويصح العكس أيضا.
حين يكون العمل السياسي متوازنا ومحكوما بقواعد لا يجوز إهمالها، حينئذ نكون أما نشاط سياسي محترَم وميدان سياسي حر، يدخله الجميع، ويتبارى فيه الفكر السياسي والرؤية الإدارية بحرية ونظام، وحين يكون النشاط السياسي متهورا عبثيا، تنهار الديمقراطية ويتم تقويض القواعد التي تضبط إيقاع العمل السياسي.
وهو ما حدث مرات عديدة في ميدان العمل السياسي بالعراق، فكما كان يحدث في هذا البلد وسواه من الدول المتأخرة سياسياً، عندما يسود الصراع بين القوى السياسية، يؤدي ذلك إلى انتزاع السلطة بالقوة الغاشمة كما لاحظنا ذلك في أسلوب الانقلابات العسكرية)، ووصول حكومات وحكام بمنطق القوة وليس الشرعية، بل بعيداً عن النهج الديمقراطي وما تؤول إليه صناديق الاقتراع من نتائج ينبغي أن ينصاع لها الجميع، مع التأكيد على نزاهتها وتقويض حالات التزوير والتلاعب في نتائجها.
السؤال الذي لابد من الإجابة عنه، لاسيما بعد حالات الإحباط والتراجع في العمل السياسي بالعراق، هل يبقى السياسيون موغلين في التعنت وفرض الرأي واللهاث وراء المناصب والمكاسب، أم عليهم الآن (ولا مجال للتأخير أو التردد)، أن يضبطوا إيقاع العمل السياسي وفق قواعد اللعبة الديمقراطية التي نادى بها الجميع، وقبلوا بها كخيار آخر مضاد للدكتاتورية؟
نحن في هذه الحالة نحتاج إلى بديل أو نقيض للتعنت السياسي، ولعلنا لا نخطئ حين نقول إن الغالبية من ساسة العراق وضعوا بديلا مضادا للتعنت وهو التنافس الديمقراطي، وقد سعى ناشطون في العملية السياسية إلى ترسيخه كمنهج عمل سياسي يتيح للعراقيين التداول السلمي للسلطة وبناء مؤسسات الدولة المستقلة بعيدا عن تدخل الأحزاب أو المدراء الذين ينتمون لكتل وأحزاب ليس همها بناء الدولة بقدر جني الفوائد المادية لا أكثر.
سؤال آخر يطرح نفسه بعد رحلة فاقت عقدا ونصف من العمل السياسي بالعراق بعد 2003، هل تبدو الساحة السياسية العراقية كما خُطِّط لها أن تكون، فضاءً ديمقراطيا قائما على التنافس السلمي بين الأحزاب والكتل السياسية، لتبادل مواقع السلطة من خلال أصوات الناخبين؟
تؤكد مخرجات العمل السياسي في العراق وجود مخاطر في طريقها إلى التفاقم، يفرزها صراع خفي بين القوى السياسية، يتحرك هذا الصراع خلف ستار ديمقراطي هش- كما أكد ذلك كثير من المراقبين- ليصبح التعنت السياسي بديلا للتنافس الديمقراطي السليم، وهذه ظاهرة خطرة ينبغي أن يتنبّه لها القائمون على العملية السياسية في العراق، بغض النظر عن الهوة الكبيرة التي تفصل بين الفرقاء، سواء في الأفكار أو الأهداف أو في وسائل العمل السياسي، لأن تحوّل التنافس إلى صراع واختلاف كلّي، يعني العودة إلى أساليب الاستحواذ على السلطة بالقوة مع تبلور منهج متشدد للهيمنة الأحادية وتضييع الفرصة الديمقراطية.
هذا يعني في حال بقيَ التعنت السياسي مستفحلا فإننا سوف نكون أمام خطر عودة الانقلابات العسكرية، وهي نتيجة تقضي بشكل تام على تطلعات العراقيين لبناء الدولة الجديدة المتحضرة التي تنتمي إلى روح العصر، لهذا لابد أن يتعلّم ويؤمن السياسيون العراقيون، أن لا عودة للصراع والاحتراب في العمل السياسي العراقي، بل هناك تنافس يستند إلى ضوابط تتضمنها قواعد اللعبة الديمقراطية التي اتفق عليها الجميع ووافقوا عليها.
لا يصح فسح المجال أمام هيمنة ظاهرة التعنت السياسي، فالجميع لهم حرية الاختلاف في الآراء والبرامج السياسية وليس الخلاف، على أن يتم ذلك تحت مظلة التنافس الديمقراطي، وقد تعلّم بعض القادة السياسيين قواعد اللعبة الديمقراطية، وقطعوا شوطا في مجال التأسيس لعملية سياسية ديمقراطية تنافسية، لا مكان لوسائل القوة في إدارتها، ولا عودة للدكتاتورية أو فرض الرأي بالقوة، فعهد التفرد بالسلطة مضى إلى غير رجعة.
وحتى يكون العراقيون في مأمن ومنأى من السقوط مجدد في براثن الأحادية والتفرد السلطوي، لابد من اتخاذ خطوات جادة عبر وثيقة أو اتفاق سياسي مبدئي يتفق عليه جميع العاملين في الميدان السياسي العراقي، تتضمن خطوطا عريضة لكنها واضحة، يلتزم بها الجميع منها:
– تنظيف الأحزاب من عقلية الاستحواذ والنزعة المادية، والركض وراء المناصب.
– تقديم هدف بناء الدولة العراقية القوية المستقرة على جميع الأهداف الأخرى.
– الانضباط التام للعمل السياسي في إطار قواعد اللعبة الديمقراطية، والاتفاق على الخطوط الحمراء التي يُمنَع عبورها أو تجاوزها.
– اعتماد الولاء الوطني كمعيار أساس في جودة الأنشطة السياسية وصنع القرارات الصحيحة.
– غلق الأبواب والمنافذ المختلفة أمام احتمالات عودة التفرّد بالسلطة وقطع الطريق أمام من يفكر أو يعلن أفضلية العودة إلى النظام الرئاسي.
– تصحيح وتشذيب القواعد الديمقراطية وتكريس النظام البرلماني، مع العمل الحثيث على تأشير أخطائه والسعي الجاد لتغييرها وتصحيحها.
– ما أفرزته رحلة السنوات الماضية التي قاربت على 18 عاما من العمل السياسي الديمقراطي، توجب غربلة دقيقة لطبيعة هذه الرحلة الشائكة واستخراج ما هو نافع منها مع طمر أخطاء الماضي بوضع بدائل تنقّي عمل الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية من هفواتها الكبرى.
1 – ان في الدستور العراقي الكثير من الايجابيات ولا يمكن ان تلمسها او تنعم بها , الا بعد تعديل صارم وواضح ودقيق للملابسات التي تم ذكرها سلفا في البحث .
2 – تثقيف المجتمع بتجاه اهمية العملية الديمقراطية وفهمها بالشكل المطلوب وتوجيه العقل الفردي والجماعي من اجل انجاح العملية الديمقراطية .
3 – تقديم بعض الحلول السريعة من اجل انعاش العملية الديمقراطية قبل ان ندخل الى مرحلة الارتداد التي تقودنا الى ماقبل التحول الديمقراطي .
4 – يجب علينا ان نتجه بتجاه العمل الجدي والفاعل والصادق لمعالجة الحالات المرضية التي انتابت العملية الديمقراطية واعتماد النظر الفلسفي والمنهج العلمي والتشخيص الواقعي للنظام الديمقراطي والسلوك السياسي المنسجم وخطوات وضوابط وشروط ذلك النظام المتبع من قبل الدول والحكومات الناجحة .
5 – على القيادات المتصدية للعملية السياسية فهم العملية الديمقراطية والايمان باليات النظام الديمقراطي وبالممارسة والسلوكيات الديمقراطية .
بهذه الطريقة نكون قد أبعدنا شبح التعنت السياسي عن العراق، ووضعنا التنافس الديمقراطي بديلا مناسبا له، بما يعزز فرص بناء نظام سياسي ديمقراطي جاد وراسخ، يمنع بشكل قاطع عودة الهيمنة الدكتاتورية ويعزز أيضا نماء المؤسسات الديمقراطية المستقلة في العراق.
يبدو أن هذه اللعبة الانتخابية قد أتقنها أنصاف السياسيين في العراق بعد أن تدربوا على أصولها الفنية، وتناسوا حقيقة أن أصل الديمقراطية هي انفراد الشعب في تقرير حاضره ومستقبله، وأن من يحكم هو موظف عنده يغيّره متى شاء، ولا ديمقراطية دون إشاعة الحرية والعدالة والمساواة والكرامة.
هناك حجج وأدلة واقعية وسياسية دامغة على انتفاء وجود ديمقراطية في عراق اليوم. رغم ما يلاحظه المراقبون من دعم أميركي لتجربة الحكم الحالية بمواصفاتها الطائفية تارة، ومن تنبيهات إعلامية استهلاكية تدعو إلى عدم “استبعاد السنة ومحاربتهم” تارة أخرى.
فالاحتلال العسكري الأميركي نقيض صارخ للديمقراطية، ومعظم اتفاقيات الحروب ومعاهداتها تعتبر جميع القوانين والتعليمات لاغية بعد رحيله، ولكن الطبقة السياسية التي صنعها الاحتلال وهيأ لها بيئة الحكم القانونية الخاضعة لإدارته لم تتجرأ حتى على وصفه بهذا الوصف الذي أطلقه على نفسه احتراماً وتقديساً لفضله التاريخي لإهدائهم مقاليد الحكم. ومنذ أحد عشر عاماً، تعم العراق فوضى سياسية وأمنية تحت مظلة اسمها “الديمقراطية الوهمية أو الواجهية” مختصرة بالانتخابات فقط، بعد أن برمج الاحتلال صيغة الحكم على مقاسات المحاصصة الطائفية، وسيطرة الأحزاب الدينية. والخبراء والمنظرون السياسيون في واشنطن يعلمون جيداً أن أبسط تقاليد الحكم الديمقراطي تقتضي إبعاد الدين ومذاهبه عن الحكم المدني الحديث، ورجال الدين مكانهم الحقيقي المساجد والكنائس، وليس كراسي الحكم في السلطة أو البرلمان.
والدولة المدنية لا تعتمد على فكرة الغالبية والأقلية الطائفية والدينية، وإنما على أساس الأغلبية السياسية ودولة المواطنة، وليست دولة الدين والمذهب، فالحكام يستغلون الدين وما يحويه من مذاهب واجتهادات لأغراضهم السياسية، وبذلك يقسمون الشعب الواحد ويفتحون أبواب الاحتراب والفتن الطائفية بين مكوناته، وهذا ما حصل بدعم أميركي مباشر ما زال قائما إلى حد اليوم.
وجاء استبدال مؤسسة الجيش العراقي التاريخية المرتبطة بتأسيس دولته الحديثة، بمجاميع الميلشيات الطائفية المسلحة، لفتح أبواب العراق أمام التنظيمات الإرهابية وخصوصاً “القاعدة” التي استثمرت واقع الاحتلال الأميركي لتتمدد داخل الحاضنات الاجتماعية العراقية التي قاومت الاحتلال العسكري، ولتصبح القاعدة العدو الأول للعراقيين من العرب السّنة إذا جاز التعبير.
لقد استخدمت المليشيات نفوذها وأدواتها المسلحة لحماية الأحزاب النافذة، ووقفت في وجه قيام رأي سياسي عراقي آخر يغذي عملية التداول السلمي على السلطة التي تشكل معياراً مهماً للمسار الديمقراطي. كما حمت المليشيات المسلحة مافيات النهب والفساد المالي وعززت نفوذها، وبذلك وضعت الموانع الخطيرة لقيام تجربة ديمقراطية حقيقية تؤدي إلى انتفاع جميع أبناء الشعب من ثروات الوطن، فلا ديمقراطية حقيقية مع هيمنة الفساد وحمايته بالقوة والنفوذ.
ومنذ الأيام الأولى للاحتلال شهدت البلاد فوضى في الحرية الإعلامية كانت مصدرها التدبيرات الخاصة لقيادة الاحتلال ومستشاريه الأميركان وبعض الإعلاميين والمثقفين العراقيين الذين تعاونوا معه، وكان من بينهم من خدموا بعض الدوائر الأميركية قبيل الاحتلال، لقاء مبالغ كبيرة تحت أغطية معظمها وهمية، وحلموا بإدارة الإعلام العراقي الحر، لكنهم صدموا بهيمنة الجهات والأحزاب الدينية التي قننت مسيرة الإعلام، وانسحب بعض الحالمين بهدوء بعد ملء جيوبهم بالملايين، والجهات الأميركية لديها قوائم أولئك “القابضين الأوائل”، التي لا بدّ أن تتسرب للرأي العام العراقي يوماً ما، فتحول المشروع الأميركي في الإعلام إلى دعم قيام مؤسسات ذات مناهج طائفية كالقنوات الإعلامية المدعومة بطرق مباشرة وغير مباشرة وقسم منها أصبح من خلال هذا الدعم ذا شأن في ميدان الإعلام العراقي، والبعض الآخر استحوذ عليه النفوذ الفئوي الضيق.
أدى الانهيار الأمني وتصاعد حالة الانقسام الطائفي خصوصاً خلال عامي 2006 و2007 إلى تقليص دوائر التعبير الحر للرأي، وتحولت حالة النقد عند السلطات الحكومية إلى اصطفاف لمعسكر التحريض على العنف والإرهاب، ومن ثم تطبيق بنود “المادة أربعة إرهاب” على هذا الصنف من الأشخاص أو المؤسسات الإعلامية العراقية. وهي بادرة وقفت ضد نشوء معمار ديمقراطي في البلاد.
وبدلاً من أن يكون الدستور حامياً للعلاقة بين الشعب والدولة، تحول إلى فتائل لتفجير الأزمات، ولم يتمكن النظام السياسي في العراق من تعميم العدالة الاجتماعية والسياسية بين الناس على أساس المحبة والسلم الأهلي اعتماداً على الدستور الذي أخفق في تفسيراته من وضع صيغ حلول صارمة لفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. والمثال الأخير المتعلق باستبعاد بعض المرشحين من قبل مفوضية الانتخابات دليل على ما وصل إليه المشهد السياسي من تدهور، حيث تصاعدت حرب التسقيط السياسي عبر الإعلام بين مجلس النواب الذي يرأسه مسؤول واحدة من القوائم الانتخابية الرئيسية المنافسة لقائمة رئيس الوزراء. كما أن استمرار نفاذ قوانين الاحتلال الهادفة إلى محاربة مئات الألوف من المواطنين وسلب حقوقهم العامة وتجريمهم بسبب انتمائهم السياسي لحزب انتهت سلطته بعد ذلك الاحتلال، لا تشكل علامة من علامات التمييز فحسب، وإنما تنفي هوية الديمقراطية الحقة. يضاف إلى ذلك العمل على إصدار قوانين اجتماعية تثير التفرقة، ولا تنتمي إلى العصر الحديث ومعايير الكرامة والمساواة “كالقانون الجعفري للأحوال الشخصية”.
إن أبرز مظهر للديمقراطية هو اطمئنان الناس وأمنهم وهذا مفقود للأسف في العراق، وليس من الصحيح ترحيل هذه المشكلة الخطيرة على العمليات الإرهابية رغم خطورتها على أمن المجتمع ووحدة نسيجه. ولعل وجود دولة قوية تعبر عن كل الشعب وتحقق العدالة لمواطنيها قادرة على هزيمة الإرهاب مهما تفنن في أساليبه القذرة.
في هذه السطور القليلة لم نستعرض كل الأمثلة التي تشير إلى عدم قيام الديمقراطية في العراق، إلا في مظهرها للعملية الانتخابية والتي تسير في منعرجات ومطبات ستزيد من احتمالات التزوير، وبذلك سيظل هذا البلد يدور في دائرته الحالية من عدم الاستقرار، وهذا ما لا يتمناه عراقي غيور على بلده وشعبه، والمسؤولية يتحملها جميع السياسيين وأنصافهم والذين ينتمون إلى العملية السياسية الجارية في العراق.