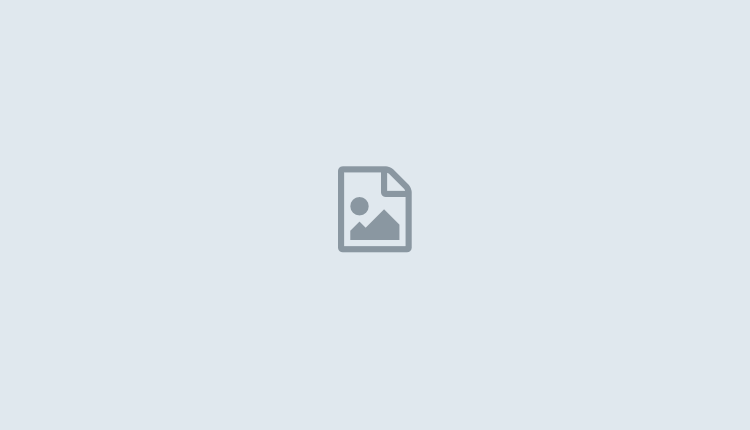حاورته- سماح عادل
“يوسف أبو الفوز”، كاتب عراقي، من مواليد مدينة السماوة، جنوب العراق، في 1956، اضطر لمغادرة العراق صيف 1979، مشيا على الإقدام عبر الصحراء إلى العربية السعودية ثم الكويت.
في الكويت للأعوام 1979 ـ 1980 كتب في الصحافة الكويتية بأسماء مستعارة عديدة، خصوصا في مجلتي العامل والطليعة وصحيفتي الوطن والسياسة، وحرر عمود سياسي ساخر باسم” دردشة” وكان أسبوعيا في مجلة الطليعة الكويتية، ووقعه باسم “أبو الفوز” الذي من يومها صار اسما فنيا له.
مقيم ويعمل في فنلندا منذ مطلع 1995. وهو عضو نقابة الصحفيين في كردستان العراق، عضو نادي القلم الفنلندي، عضو المنظمة الثقافية للكتاب والفنانين الفنلندية المعروفة باسم Kiila، أسست 1937، وانتُخب لعضوية هيئتها الإدارية لعدة دورات، منذ 2006، كأول كاتب من الشرق الأوسط يُنتخب لهذا الموقع. درَّست بعض المدارس الفنلندية الثانوية وجامعة هلسنكي نماذج من قصصه، ونوقشت بحضور الكاتب. إضافة إلى لغته الأم العربية يتحدث الكردية والإنجليزية والروسية والفنلندية. إلى الحوار:
** في رواية (كوابيس هلسنكي) تحدثت عن خطر عنف التشدد الديني على أوربا، ولم تحمل الجماعات وحدها سبب ذلك العنف، حيث أرجعت أحد الأسباب إلى تجاهل الحكومات الأوربية إدماج اللاجئين خاصة المسلمين منهم في المجتمع الأوربي بقيمه وقوانينه.. حدثنا عن ذلك؟
ــ انتهيت من العمل في هذه الرواية عام 2008، وجاءت أثر دراسة متفحصة استمرت لأكثر من عامين، لنشاط الجماعات التكفيرية في البلدان الأوربية، خصوصا فنلندا. أردت منها أن تكون صرخة تحذير وتنبه إلى واقع معاش، وأيضا تكشف عن عجز الحكومات الأوربية، والمؤسسات المعنية في إيجاد سياسات اندماج فاعلة وناجحة لاحتواء الشباب المهاجر، خصوصا القادمين من البلدان الإسلامية، مما وفر مناخ مناسب لنجاح الجماعات المتأسلمة والتكفيرية الناشطة بفعالية، في كسب أعداد ليست قليلة من الشباب إلى صفوفهم، خصوصا ممن يعانون من البطالة والتهميش. كَتبت الرواية قبل تأسيس منظمة (داعش) وإعلانها رسميا ويمكن القول إنها تنبأت بظهورها، كما أشار إلى ذلك الأستاذ علاء المفرجي في معرض كتابته عن العمل بعد صدوره، كونها استقرئت الواقع والمستقبل. إن سياسة التوطين على شكل (غيتوات) معزولة، المتبعة في العديد من الدول الأوربية، ساهم في تقوقع المهاجرين على أنفسهم. من جانب آخر، إن سياسة الدول الأوربية في التعامل مع الجماعات الدينية، على اختلافها، كونها (مؤسسات ثقافية)، منحها فرصة استغلال آلية الديمقراطية الأوربية لمد نشاطاتها وامتلاك أماكن خاصة بها، بحجج العبادة وأداء الطقوس، لكنها تحولت عمليا إلى أماكن للتقوقع والتنظيم وللتثقيف الخاص، سواء ضد المدنية والتطور الحضاري أو للتنظيم لأغراض تكفيرية وجهادية. خصوصا تلك الأماكن التي تم بناءها أو استئجارها بمساعدة أموال خليجية. في ندوات عامة وأحاديث لوسائل الإعلام، أقول دائما للفنلنديين أن التعدد الثقافي لا يعني تذوقك للكباب والدولمة وسماع شريط موسيقي عربي أو أفغاني، أنه يتمثل في دعم سياسة اندماج حقيقية، والسعي لمحاولة فهم أن المهاجر لا يقطع تذكرة باتجاه واحد، وكونه يبقى مرتبطا بجذوره وثقافته، من هنا ضرورة دعمه للحفاظ وتطوير ما هو ايجابي وإنساني في ثقافته الأم ومساعدته لامتلاك معارف وتجارب حضارية جديدة ومنح عموم المهاجرين واللاجئين، والشباب خصوصا، المزيد من الفرص في العمل والتوظيف في مؤسسات الدولة ليكونوا جزء منتجا ومثمرا من المجتمع، وزجهم في النشاطات والفعاليات ليس باعتبارهم ديكورا أو رقما انتخابيا وإنما جزء من نسيج المجتمع. ما زلت أرى أن أوربا بانتظارها الكثير لتعمله لأجل انجاز عملية اندماج حقيقية. ويجب التأكيد على أن عملية الاندماج، هي مهمة مشتركة ومتبادلة، فالمهاجرين واللاجئين عموما مطالبين بأن يكونوا إيجابيين ومتسامحين في فهم متطلبات الحياة في هذه البلاد الأوربية العلمانية المتطورة، ما داموا اختاروا بأنفسهم القدوم إليها، فعليهم السعي لتعلم لغة البلاد واحترام قوانينها والسعي لاحترام ثقافة وعادات المجتمع. إن البعض من الأخوة المهاجرين، للأسف، يفهم أن هدف الاندماج وكأنه التنكر لهويته الوطنية، وهو هنا يخلط بين ما نسميه (الانصهار) وبين عملية (الاندماج). أن الاندماج هو عملية طويلة وعميقة ولها عدة مراحل، وإذ تحرص فيها على الحفاظ على الأساس الإيجابي من هويتك وجذورك، يتطلب مراعاة قوانين وثقافة البلد الأوربي. وقبل أن تطالب بحقوقك عليك أن تعرف واجباتك أولا وعندها ستكون المعادلة متوازنة.
** في رواية (كوابيس هلسنكي) اخترت إطارا خياليا يتمتع البطل فيه بقدرات كشف الحقائق عن طريق الأحلام، وقدمت نموذج للشرطي المتعجرف، وللمتشدد الديني الملتوي المتلون، هل هناك بالفعل خطر أن ينفجر عنف الجماعات المتشددة دينيا في أوروبا، وماهي المؤشرات في رأيك؟
ــ حوت الرواية، شخصية ضابط شرطة، ينعته الراوي بلقب (الجنرال)، قاد التحقيق مع الراوي، الذي جاء بنفسه للشرطة يحمل معلومات ما عن جماعة إرهابية. أرادت الرواية أن يكون هذا (الجنرال) ممثلا للمنظومة البوليسية، وأجهزة الدولة المعنية بقضية الأمن، وأساليب تعاملها مع موضوع الإرهاب، وليس بدون معنى أظهرت الرواية العجز الجنسي للجنرال في معرض الحديث عنه. فالأجهزة الأمنية الأوربية ظلت لسنوات طويلة عاجزة ومشغولة بتفاصيل ثانوية بدل التركيز على ما هو أساسي، وتطلب منها وقتا لتخرج باتفاقات أمنية موحدة، بينما المنظمات التكفيرية، سبقتها وتجاوزتها في التنسيق والعمل، وكان هذا واضحا في القدرات على التجنيد وتمكن العشرات بل المئات من حاملي الجنسيات الأوربية، خصوصا من الشباب ومن مواليد هذه البلدان، من الالتحاق بالمنظمات المتطرفة والإرهابية كالقاعدة وداعش في العراق وسوريا، رغم عيون البوليس الأوربي المنتشرة في كل مكان. وهؤلاء (المجاهدين) تزودوا بالخبرة والمعرفة بأساليب التخريب والإرهاب وعاد العشرات منهم إلى بلدانهم ليكونوا نوات وبؤر مستقبلية لمنظمات تعمل تحت السطح ستظهر نتائج أعمالها يوما ما تبعا للظروف والأزمات، طالما أن أسباب تشكيل وظهور هذه المنظمات لا يزال قائما. وأن أعمال العنف يمكن أن تتفجر لأي حجة تنفخ الرماد عن جمّر الأسباب الكامنة، وعندها تستطيع الجماعات التكفيرية والمتشددة استغلاله لتنفيذ سياساتها الإرهابية.
** في رواية (كوابيس هلسنكي) أكدت على أن العنف ليس مرتبطا بالإسلام كدين، وأن العنف معروف في تاريخ الإنسانية بشكل عام، وفي تاريخ أوربا والغرب بشكل خاص، هل ذلك كان في مواجهة ما يحاول الإعلام الغربي تكريسه دوما من أن العنف مرتبط بالدين الإسلامي؟
حاولت الرواية أن تقدم قراءة ما في تأريخ العنف عموما، لتقول لنا بأن العنف لا يرتبط بالدين فقط، كما شهد تأريخ أوروبا تبعا لسياسة الكنيسة الأوربية في القرون الوسطى، ولا بالإسلام التكفيري، كما شهدت العقود الأخيرة الماضية، بل أن العنف مرتبط بأسباب اجتماعية وسياسية أيضا، وان الدين ما هو إلا غطاء للجهات والطبقات المنتفعة من هذا العنف، والذي يمكن أن يندلع في أي مكان لأسباب لا علاقة لها بالدين فقط. اجتهدت الرواية في الحديث عن آليات عمل الجماعات التكفيرية، واستغلالها الدين كغطاء، من خلال متابعة إحداث وأعمال إرهابية متخيلة في بلد أوربي مثل فنلندا، وحاولت استقراء نتائج التشدد والتطرف السياسي والديني في أوربا، وأطلقت صرخة تحذير من أن أسباب العنف والإرهاب اجتماعية واقتصادية قبل أن تكون دينية، وهي كامنة ويمكن أن تنفجر في أي حين عند توفر الظروف المناسبة، وهكذا فالرواية تحدثت عن أعمال عنف سبق وحصلت في فرنسا وفنلندا وحذرت من احتمال تجددها في أي مكان من أوربا، كما حصل في لندن والنرويج لاحقا بعد صدور الرواية، والرواية أيضا ربطت بشكل مباشر الأحداث بما حصل في العراق من نتائج الاحتلال الأمريكي ونشاط المنظمات التكفيرية في التجنيد والتمويل والتدريب والإسناد. ولابد من القول بأن الرواية كذلك تحذر من اندلاع العنف على يد منظمات اليمين المتطرف الأوربية، أو أحداث فردية، كرد فعل على واقع اجتماعي. وما يسجل لصالح الرواية أن بعض مما حذرت منه تحقق بشكل أو آخر، في العديد من البلاد الأوربية، ومنها فنلندا، والأمر هنا ليس عملية تنجيم، وإنما هو عملية استقراء للواقع، فالرواية صدرت خريف عام2011 تحمل على غلافها صورة شبح رجل يحمل سكينا على خلفية دموية، وفي فنلندا ظهيرة 18 آب 2017 أندفع شاب داعشي في ساحة عامة وهو يهتف (الله وأكبر) بذات المنظر في صورة غلاف الرواية وقتل بسكينه امرأتين وجرح ثمانية آخرين قبل أن يوقفه رصاص الشرطة.
** سافرت إلى السعودية ثم الكويت سيرا على الأقدام في الصحراء هل ما عانيته في العراق كان له تأثير على أدبك.. وكيف ذلك؟
ـ في نهاية سبعينات القرن الماضي، عاش العراق سنينا عصيبة، مع صعود وسيطرة جناح صدام حسين في حزب البعث العراقي، وأتباع سياسة (تبعيث المجتمع) فشنت مختلف الأجهزة الأمنية، حملة بوليسية، استهدفت الآلاف من أبناء الشعب العراقي، من كتاب وفنانين ومثقفين، ممن رفضوا الانضمام لصفوف حزب البعث، وممن كان له أفكارا مختلفة، بغض النظر عن كونهم شيوعيين أو ديمقراطيين غير متحزبين، مما أدخل البلاد في دوامة من العسف السياسي المنظم، فأضطر الآلاف من هؤلاء لترك البلاد بطرق مختلفة. كنت وأفراد عائلتي، من الرافضين لسياسة التبعيث، فنلنا حصتنا من المداهمات والاعتقالات والمطاردات. شخصيا اضطررت لترك دراستي الجامعية ربيع عام 1978 والاختفاء والعيش بشكل سري مطاردا في وطني لحوالي عام ونصف، ذاقت خلالها عائلتي، خاصة أمي، الويل من قسوة أجهزة حزب البعث، مما اضطرني في النهاية لترك وطني والابتعاد عن أهلي وأحبتي، ولتعذر السفر عبر المنافذ الرسمية، كوني مطلوبا للأجهزة الأمنية، اضطررت إلى السفر عبر الصحراء متخفيا مع البدو الرحل في رحلة قاسية، في شهر تموز 1979، إلى العربية السعودية وثم إلى الكويت، فقط لأجل الحفاظ على حياتي وكرامتي. كنت مطلوبا للسجن أو التصفية، كحال ألاف من أبناء العراق، فقط لكوني تحدثت وعملت وكتبت لأجل مستقبل أفضل للإنسان العراقي، بطريقة مغايرة لما يريده الحاكم الأوحد. بالتأكيد أن كل هذا ترك أثره البالغ على مسار حياتي وكتاباتي. إن هذه المعاناة والتجارب، والحلم الدائم بعراق مدني ديمقراطي تحكمه المؤسسات، وحياة حرة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وامتلاك مساحة واسعة من الحرية للكتابة بعيدا عن كل (التابوات) المعروفة، كل هذا يفرض وجوده كموضوعات في أعمالي الأدبية ونشاطاتي الثقافية. في رواية (كوابيس هلسنكي) اجتهدت لعكس جزء من هذا ومن خلال تطلع بعض شخصيات الرواية لعالم مختلف. وفي عموم أعمالي القصصية والروائية، أحاول باستمرار فضح العنف السياسي ضد الإنسان، وأكشف زيف الأنظمة الديكتاتورية المتسلحة بالفكر الشمولي، مهما كان لونه، ديني أو دنيوي، وإن معظم شخصيات أعمالي المنشورة تمجد الحرية وتحلم بها بل ويقدمون حياتهم ثمنا للنضال لأجلها.
** انضممت إلى الأكراد للنضال معهم احكي لنا عن تلك الفترة والتي أثرت أدبك فيما بعد؟
ـ من بعد حوالي أربعة أعوام من العيش خارج العراق وعشت وعملت في العربية السعودية والكويت واليمن الديمقراطي، كان قراري بترك الحياة في المنفى، والعودة للوطن والالتحاق بحركة الكفاح المسلح ربيع 1983، ضمن صفوف مقاتلي وفدائي الحزب الشيوعي العراقي، الذين عرفوا باسم (قوات الأنصار)، وكان قرارا واعيا. وكانت منظمة سياسية عسكرية عراقية مستقلة عن التأثيرات الإقليمية والدولية، عملت في مناطق كردستان العراق، الجبلية، ونالت تأييد ودعم أبناء الشعب الكردي الذين فتحوا أبوابهم لها، وكانوا مصدرا أساسيا لاستمرار ودوام الحركة، وتعاونت منظمة الأنصار مع القوى الكردية العاملة في المنطقة لأجل زوال النظام الديكتاتوري. كنت أدرك، مثل غيري، أن بنادق الأنصار لن تسقط نظام صدام حسين الديكتاتوري، لكنها ستساهم في زعزعة نظامه، وتكون عاملا للتعجيل بتفكيكه وثم سقوطه ليترجل حصان جواد سليم ويملأ العراق صهيلا. لم يترك النظام الديكتاتوري حينها لأبناء جيلي فرصة، للعمل السياسي الديمقراطي لأجل التغير سوى انتهاج أسلوب الكفاح المسلح.
هذه الفترة، التي استمرت بالنسبة لي حوالي ثمان سنوات، كانت غنية جدا، ليس فقط بتفاصيل الحياتية اليومية، وصعوباتها التي كنا نواجهها كل يوم بل وكل ساعة، حيث تفتقد حياة الأنصار لأبسط متطلبات الحضارة، في أبسط قرية، إذ كنا نعيش في كهوف ووديان زاحمنا الذئاب والثعالب عليها، بل لأن تلك السنوات الوعرة كانت فرصة لاختبار النفس والمبادئ ولفهم أهمية الحياة الأفضل ومواصلة العمل لأجل ذلك حد الاستشهاد، خصوصا كوني عشت تلك السنين البهية مع كوكبة رائعة من شباب العراق من كل المكونات، يربطهم الانتماء للوطن، والذين وهبوا أنفسهم وحياتهم لقضية سامية متخلين عن حيواتهم في البلدان الأوربية، حالمين مثلي بيوم سقوط القتلة. وبينهم جمهرة كبيرة من المثقفين والكتاب والفنانين المحترفين ذوي الخبرة، ومنهم من صاروا أصدقاء لي تعلمت منهم الكثير. وهكذا، وجدت نفسي هناك أكتب باندفاع وحيوية وأتعلم كل يوم، فكتبت القصة القصيرة ونصوص نثرية وشعرية والمقالات، نشرت في دوريات أدبية مختلفة وصدر بعضها لاحقا بكتب مستقلة. في كل هذه النصوص، كان للمستقبل الذي نحلم به ولأجل الأجيال القادمة المساحة الأرحب، وكنا ندرك بأننا نعمل لمستقبل لن نراه، وكنا نواصل الكفاح بإصرار واستشهد لنا على يد قوات ومرتزقة النظام الديكتاتوري العشرات من خيرة شباب العراق، بينهم أعداد ليست قليلة من الكتاب والفنانين الواعدين. لقد رسخت سنوات الحياة في الجبال فكرة أن الأعمال العظيمة لا يمكن إنجازها دون مشاركة الآخرين، وأن بناء المستقبل الأفضل للناس ليس مشروعا فرديا أبدا. في الجبل، كانت الحياة قاسية، وخشنة جدا، وحقيقية بشكل مريع. لا يوجد زيف فيها، فتعلمنا عمليا بأن الشجاعة فعل مكتسب، والشجاعة هنا ليس على صعيد الأعمال العسكرية، إذ كانت هذه في الغالب دفاعا عن النفس، لأن حركة الأنصار لم تكن ذات إستراتيجية هجومية أبدا، وأقصد هنا الشجاعة الفكرية والاجتماعية. وهكذا أستطيع القول إنه حتى مؤسسة سياسية مثل الحزب الشيوعي العراقي، نمت وتطورت أفكار التغيير في داخلها وضرورة إعادة بنائها على أسس أفضل بين المقاتلين الشيوعيين في الجبل. كل هذا انتقل بهذا الشكل أو ذلك للكتابات التي أنجزتها في الجبل وما تلا ذلك، ويشرفني أن مجموعتي القصصية (عراقيون) التي طبعت في آب 1985 كانت أول مجموعة قصصية تطبع هناك وفق الإمكانيات المتواضعة التي تملكها الحركة الأنصارية. ولاحقا صدرت لي كتب أخرى كتبت أساسا في سنوات الجبل، مثلا كتاب (تضاريس الأيام) صدر سنة 2002، وكتاب توثيقي بعنوان (أطفال الأنفال) 2004 وفي 2020 صدرته ترجمته إلى اللغة الكردية ومجموعة قصصية بعنوان (تلك القرى… تلك البنادق) 2007، ترجمت المجلة الكردية الثقافية چيا (الجبل) بعض نصوصها، على أمل استكمالها لاحقا ونشرها ككتاب مستقل.
**هل يمكن الحديث عن نهضة ثقافية في الأدب العراقي وما هي الأسباب؟
ـ إن هذه العملية معقدة جدا، فمتطلبات النهضة الثقافية في العراق متعددة ومتداخلة، وللأسف لا تتوفر الأهم منها حاليا. من ذلك غياب وجود شريحة أو فئة مثقفة متجانسة قادرة على خلق هذه النهضة أو المساهمة فيها، وأيضا غياب فعالية مؤسسات ديمقراطية وأطر ثقافية قادرة لرعاية ودعم هذه النهضة، في بلد تقوده فعليا جماعات الإسلام السياسي ويتسيد الشارع فيه سلطة المليشيات الطائفية، في حين تنتشر الأمية وتغيب الوعي ويشهد النظام التعليمي فيه تدهورا مريعا. ولا ننسى أنه خلال سنوات الحكم الديكتاتوري البعثي، وسيادة سياسة الحزب الواحد، وثم مجيء الاحتلال الأمريكي ومؤسساته، وثم ما أنتجه من حكومات المحاصصة الطائفية والإثنية، ولعدة عقود، تعرضت الثقافة العراقية لنكسة مريعة، إذ تهدمت البنى التحتية للدولة العراقية واختفت العديد من المؤسسات المدنية الفاعلة وتشوه تركيب المجتمع العراقي، مع زوال الطبقة المتوسطة، وظهور طبقة طفيلية ساعدت على انقسام المجتمع العراقي طائفيا وإغراقه في الطقوس الغيبية ترافقا مع نتائج حكم المليشيات الطائفية. وإن التدهور الكارثي في حياة البلاد الاقتصادية، في القطاعات الصناعية والزراعية، وواقع كون العراق بلدا ريعيا، يعيش على عوائد النفط فقط، يعني أنه بلد غير منتج لأي بضاعة، فهو بلد استهلاكي أولا، وغالبية العاملين في حقل الثقافة يتعاملون مع الدولة الريعية كموظفين. أيضا أن تركة النظام البعثي الثقيلة خلفت لنا، ضمن ما خلفته، كمّا من أنصاف المثقفين أكثر من المثقفين الحقيقيين، وجاءت حكومات المحاصصة الطائفية فزادت من الطين بلة، وانتفاضة أكتوبر العام الماضي فضحت ذلك جدا، فغالبية المثقفين للأسف، كانوا بلا موقف، يتحركون في منطقة أسميتها في مقالات لي ولقاءات صحفية، (المنطقة الرمادية)، فهم لا يريدون اتخاذ موقف يثير غضب مؤسسات الدولة، التي يعملون موظفين لديها، ولا إزعاج المليشيات الطائفية التي تتسيد الشارع، وبنفس الوقت يتملقون الثوار بإعمال أدبية وفنية سطحية، فكيف لهؤلاء أن يساهموا في نهضة ثقافية؟ كيف لمجتمع استهلاكي لا ينتج أي بضاعة، أن ينتج نهضة فكرية. أن العراق يحتاج إلى دورة عدة أجيال قادمة، لم تتلوث بكل هذا الذي حكينا عنه، لينهض من كبوته الحادة ويستعيد مكانته المنشودة.
** حصلت على عضوية المنظمة الثقافية للكتاب والفنانين الفنلندية المعروفة باسم “Kiila”، وانتخبت لعضوية هيئتها الإدارية لأكثر من دورة، كأول كاتب من الشرق الأوسط ينتخب لهذا الموقع. كيف كان تفاعلك الثقافي خارج العراق، كيف استطعت أن تتواجد وتفرض وجودك ككاتب؟
ــ أنا فخور جدا بما حققت في فنلندا، على صعيد مجمل نشاطاتي، الثقافية والسياسية والاجتماعية. بذلت جهدي واجتهدت في العمل وكان العراق المدني الديمقراطي الذي حلمنا به هو الهم الأول دائما. فمنذ الأيام الأولى لوصولي إلى فنلندا كلاجئ لأسباب إنسانية مطلع عام 1995، تواصلت مع المنظمات والجمعيات الفنلندية، ككاتب وناشط سياسي واجتماعي. شاركت في كثير من الفعاليات الثقافية والسياسية داخل العاصمة وخارجها، فتولدت لي شبكة واسعة من المعارف والأصدقاء، خصوصا من المثقفين والعاملين في الوسط الثقافي والإعلامي، فساعدتني لتلمس طريقي بشكل أوضح. ككاتب وصحفي ولغياب وجود إطار ثقافي واجتماعي عراقي أو عربي، تواصلت مع المنظمات الثقافية الفنلندية التي نلت عضوية بعضها من خلال نشاطي وعملي بين صفوفها. والشعب الفنلندي شعب مثقف، محب للقراءة، فالمكتبات العامة تعمل كمراكز ثقافية، وتوجه الدعوات للكتاب لإقامة أمسيات ثقافية بناء على اقتراحات من القراء، هكذا سافرت شخصيا لعدة مدن فنلندية تلبية لمثل هذه الدعوات. ولابد من القول إن صدور كتابي (طائر الدهشة) عام 2000 مترجما إلى اللغة الفنلندية من قبل الدكتور ماركو يونتنين، وإذ نال إقبالا جيدا، عَرّف الفنلنديين أكثر باسمي ونشاطاتي وفتح لي المزيد من الأبواب للنشاطات الثقافية والاجتماعية والإعلامية. أيضا أن عملي في التلفزيون الفنلندي ولاحقا كباحث جامعي، ساهم أكثر في فتح المزيد من الأبواب، وسهل لي التعامل والعمل مع العديد من المؤسسات الفنلندية الثقافية والأكاديمية. وساهم الإعلام الفنلندي من خلال متابعته نشاطاتي بالتعريف بها. ثم جاء منحي (جائزة الإبداع) السنوية عام 2015، من قبل منظمة (كيلا)، ولأول مرة تمنح لكتاب من أصول أجنبية، و(كيلا) منظمة ثقافية عريقة تأسست عام 1936، ليعزز هذا أكثر من حضوري ونشاطاتي في الوسط الثقافي، أعقبها أن مدينة كيرافا (ضواحي العاصمة هلسنكي)، محل سكني، كرمتني بمنحي راية المدينة تقديرا لنشاطاتي وأعمالي التطوعية في المجال الثقافي والاجتماعي، وهذه أيضا أول مرة تمنح لمواطن من أصول أجنبية، وسبق ذلك في عام 2014 اختياري من جمعية الأدب الفنلندي، المعنية بحفظ التراث الأدبي في فنلندا، كأول كاتب من الشرق الأوسط، لتحفظ أعماله وقصة حياته وتفاصيل عن عمله ونشاطه الثقافي، ضمن أرشيفها المتاح للباحثين والمعد للحفظ للأجيال القادمة، علما أن الجمعية تأسست عام 1831، وتضم في أرشيفها أعمال المئات من الكتاب الفنلنديين. إن المثابرة في العمل والنشاط لخدمة الناس والمجتمع، والاجتهاد لتقديم دائما الأفضل، ساهم كثيرا في تعزيز شخصيتي ككاتب عراقي عربي مقيم في بلد أوربي. واجتهدت في عموم عملي ونشاطي لأكون صارما وجادا في التعامل مع الوقت وأداء أي مهمة أقوم بها، وساعدني كثيرا تحدثي بأكثر من لغة وكوني تعلمت احترام الرأي الآخر المختلف وتعلمت عرض أفكاري بشكل صريح دون المساس بمعتقدات الناس وأفكارهم. ولا يمكن هنا تجاوز أن شريكة حياتي وحبيبتي وملهمتي شادمان كانت من أهم أسباب نجاحاتي، إذ كانت صخرتي التي استند إليها دائما في كل حين.
** في رأيك هل تحاول الرواية العراقية توثيق ما حدث في المجتمع العراقي طوال السنوات الفائتة من قمع ووحشية، سواء من النظام السابق أو من الاحتلال الأمريكي.. وما مقدار نجاحها في ذلك؟
إن الأعمال الروائية، بمختلف مدارسها، تندرج بهذا الشكل أو ذاك، في كونها أعمال بحثية أنثروبولوجية تطبيقية، تدرس الإنسان والمجتمعات. من هنا، فإن كل عمل روائي، يجتهد ليس لكشف معاناة شخوصه، بل وللإحاطة بالظروف الاجتماعية والسياسية، والإحاطة بتفاصيل المكان، وكثير من التفاصيل الأخرى، فالسرد سيكون هنا راصد حيوي لجميع مناحي الحياة، بل وفي جانب منه يكون عملا توثيقيا هاما.
وإن رواية مثل (المخاض ــ صدرت عام 1974) للكاتب الرائد الراحل غائب طعمة فرمان، تعرض للقارئ ليس فقط معاناة بطلها الباحث عن أهله من بعد غياب سنين خارج العراق، ونبذة عن التغيرات الاجتماعية والسياسية، بل وأجواء وروائح وتفاصيل منطقة المربعة في بغداد منطقة سكن بطل الرواية، في تلك الحقبة.
وأيضا أن رواية مثل (مقتل بائع الكتب ـ صدرت 2016) للكاتب للراحل سعد محمد رحيم، تكون من الأمثلة المناسبة، للأعمال الروائية التي تتحدث عن فترة ما بعد ديكتاتورية نظام صدام حسين، فمن خلال استخدام المذكرات والرسائل والتأملات ارتباطا بشخصية المكتبي بطل الرواية، استحضر لنا الكاتب حياة شريحة المثقفين بكل الالتباسات التي عاشوها من تهميش ومضايقات ونفي وثم اغتيال، ونتعرف في الرواية لواقع العراق والتقلبات السياسية والاجتماعية ونطلع على صفحات من تأريخه المأساوي ونتائج حروب الديكتاتور صدام المجنونة وثم أيام الاحتلال الأمريكي وتسيد المليشيات الطائفية. وإن براعة أي كاتب في السرد هنا غير كافية وحدها، ليكتب لنا أعمالا أدبية تنجح في التوثيق لما حدث في المجتمع العراقي من قمع ووحشية، إن الكاتب مطالب بامتلاك موقف واع في رفض هذا القمع ومن يقف خلفه، سواء كان سلطة دينية أو دنيوية، والتحريض ضده، ومن هنا فإن هذه الكتابة ستكون أمينة للشرط الإنساني، والانتصار للإنسان كقيمة عليا في هذه الحياة. وفي هذا الأمر، أجدني متفائلا مع وجود العديد من الأسماء من كتاب القصة والروائيين العراقيين، البارعين في مهمتهم، وعلى يدهم اعتقد أن القصة والرواية العراقية ستنجح لتحقيق رسالتها الأساسية
** قمت بالمشاركة في عمل أفلام تلفزيونية عن العراق وعن المنفى واللجوء.. كيف قوبلت تلك الأفلام من الجمهور الفنلندي؟
ـ عملت وتعاونت مع القسم الثقافي في التلفزيون الفنلندي لعدة سنوات، فقدمت فكرة سيناريو فيلم لقسم الأفلام الوثائقية، تم قبولها ثم بعد انجاز السيناريو، ومناقشته، تم تكليفي بإخراجه، وبقدر ما كانت ممتعة كانت تجربة متعبة جدا، اجتزتها بدعم من زملائي فريق العمل من القسم الثقافي، هكذا قدمت فيلمي الأول (رحلة سندباد) عام 2000، كان من نصف ساعة، افترضت فيها رحلة ثامنة للسندباد البحري يقوم بها الشعب العراقي في هجرتهم إلى بقاع العالم هربا من عسف ديكتاتورية البعث وحروبه المجنونة ووصول بعض منهم إلى فنلندا كلاجئين. وتم عرض الفيلم مرتان من خلال البرنامج العام للتلفزيون، وفي مهرجان خاص باللاجئين وفي نشاطات بعض المنظمات المعنية بالهجرة. ثم في عام 2006 أنتج التلفزيون الفنلندي فيلمي الثاني، (عند بقايا ذاكرة)، وكنت عندها تسلحت بتجربة عمل جيدة، وفي نصف ساعة حاولت بالصورة، مناقشة فكرة التغيرات في العراق من بعد سقوط نظام صدام حسين. لم يحاول الفيلم تقديم الانطباعات بنبرة سياسية مباشرة، بل حاول تقديمها بشكل إنساني دون تعليق مباشر تاركا للصورة أن تتحدث وإثارة الأسئلة أكثر مما تقدم أجوبة. فبعد أن توفرت لي فرصة زيارة العراق من بعد غياب 27 عاما، وبالنسبة لشادمان شريكة حياتي زيارة كردستان من بعد غياب تسع سنوات حاولت رصد ذلك بالكاميرا. أية انطباعات وأية أسئلة في البال؟ ماذا تبقى من الزمن الماضي وتغير؟ كيف تحرك العراق من احتلال حزب البعث للعراق إلى احتلال أمريكي؟ وفي حينه، تم اختيار الفلم لافتتاح الدورة الجديدة لقسم البرامج الثقافية في التلفزيون الفنلندي، وعرضه التلفزيون لأربع مرات خلال عدة أسابيع. وكان هناك عرض خاص للمراسلين الأجانب بحضور المخرج وأعضاء من فريق العمل، في المركز الصحفي في وزارة الخارجية الفنلندية، وعرض عام ضمن الفعاليات الثقافية لبرنامج منظمة “كيلا” الثقافية، وعروض للجالية العراقية، وثم توّج ذلك باختيار الفيلم لتمثيل فنلندا في مهرجان في سويسرا. أستطيع القول أن عملي في انجاز الأفلام الوثائقية، وتعاملي مع الصورة، شحذ كثيرا من إمكانياتي في الكتابة وطور من أدواتي، وانعكس كثيرا في كتابة رواية (كوابيس هلسنكي)، إذ استعرت من حرفة السينما بعض أدواتها عند الكتابة. ولابد من القول أن في كلا الفيلمين، كان إلى جانبي لإنجاز كل فيلم، فريق عمل محترف في الإدارة والتصوير والمونتاج، إذ استغرق انجاز كل فيلم عدة شهور من العمل المتواصل ساده التعاون والتكاتف.
** ما تقييمك للنقد في العراق وهل واكب الإنتاج الغزير خاصة فيما بعد 2003؟
ـ كتبت عن حال النقد في العراق، مقال نشر خريف 2011، في الصحافة العراقية وعدة مواقع اليكترونية، صرخت فيه وطالبت النقاد أن يشتمونا، نحن الكتاب المساكين إن شاءوا، المهم أن يكتبوا شيئا. ولا أعتقد أن الحال تغير من ذلك اليوم، فلا يوجد لدينا، حركة نقدية موضوعية رصينة، شأن بقية شعوب العالم، رغم وجود نقاد، بعضهم لهم قدرات فذة في الكتابة والتحليل، والأمر متعلق بعموم الواقع المريع الذي تعاني منه الثقافة العراقية وعموما الثقافة العربية. وإن كل ما ترينه ـ سيدتي ـ من إنجازات في الأدب هو إنجازات فردية لكل الكتاب وحتى الفنانين أيضا، عراقيين أو عرب، فكل كاتب ـ إن صح التعبير ـ أراه “ذئبا منفردا” يعوي في صحرائه الخاصة. حين صدرت رواية (كوابيس هلسنكي) وذهبت لتوقيع الكتاب في بغداد وكان يوما مفعما بالمشاعر، همس لي أحد المعارف باني بحاجة إلى دعوة عشاء سمك مسقوف على نهر دجلة أو حفلة في مطعم فاخر ليقتنع الناقد الفلاني والعلاني بجودة عملي ليكتب عنه عدة مرات لا مرة واحدة. لم استغرب هذا أبدا، فللأسف إن الحال وصل بـ (أمة اقرأ) أن تكون المحاباة والإخوانيات عند بعض نقادنا على حساب جودة الإبداع الأدبي. أيضا، هناك إشكالية هامة، تتعلق بالناشر العربي، فهو يعتقد أن مهمته تنتهي فقط عند طبع الكتاب وعرضه في المكتبات، بينما في العالم المتحضر، يتولى الناشر مهمة الاتصال بوسائل الإعلام وأهم المجلات الثقافية ومؤسسات الترجمة، وشركات السينما والتلفزيون، للتعريف بالكتاب، لينال حظوته من الاهتمام والتقدير المناسب وبالتالي يساهم كل ذلك في تسويقه.
* آخر رواية لك (كوابيس هلسنكي)، صدرت عام 2011، هل هذا كسلا أو تأني في الكتابة، أم لديك تفسير للقراء؟
ــ على طاولتي ـ ياسيدتي ـ ترقد عدة مخطوطات أدبية قيد العمل وبعضها جاهز للطبع، ولدي الآن خمس كتب عند الناشرين، روايتان ومجموعتان قصصية وكتاب عن السينما، بعضها ينتظر أكثر من أربع سنوات والآخر ثلاثة. أستطيع القول إني غزير الإنتاج في الكتابة، بل وربما جدا، فما أن انتهي من مشروع، حتى انتقل لمشروع آخر، وحصل أن عملت بأكثر من مشروع في آن واحد. أن مشكلتي ــ إذا كان هذا مشكلةــ إني لا أدفع للناشرين مقابل طباعة كتبي، كما أني لا أريد أن أغتني منها. هكذا تجديني مجبرا للخضوع لاجتهادات، بل ويمكن القول رحمة الناشرين، حتى يطبعوا المخطوطات التي سلمتها لهم وأأتمنتهم عليها. ولا اعتقد أن هذه مشكلة شخصية أو فردية فهي مشكلة عامة، ستستمر طالما غاب وجود المؤسسات الثقافية التي تتعامل مع الكُتّاب والكِتاب بشكل موضوعي ووفق معايير رصينة، ومنها تلك التي تحدد وترسم علاقة الناشر بالكِتاب وتضمن حقوق الكاتِب.