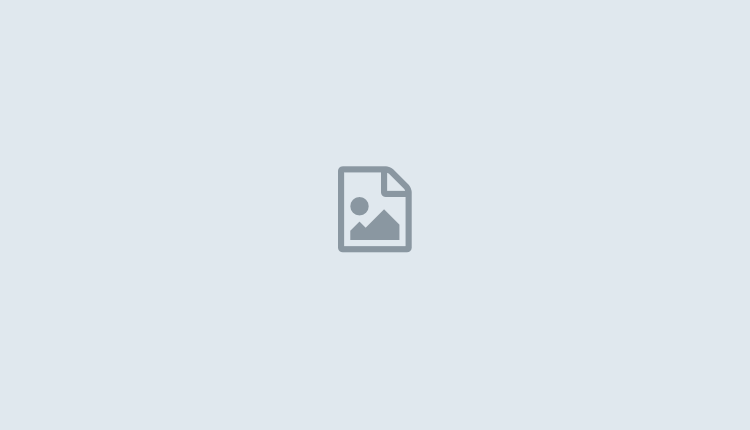لقد مر على العراق خمسون عاما من سوء الإدارة والعسكرة والأخطاء المتراكمة، التي أنتجت الوضع المريع الحالي، فيما كان يمكن أن يكون الاقتصاد العراقي من أقوى الاقتصادات في المنطقة.
ودون الاستغراق في سرد أحداث الماضي، فقد بدأ العراقيون مطلع السبعينيات بالسعي وراء التوظف في مؤسسات الدولة، خصوصا في المؤسستين العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والصحية والبلدية، وكانت الحكومة قادرة على التوظيف حينها بسبب العائدات النفطية الهائلة. وقد أدى هذا التوظيف إلى انتقال الأيدي العاملة من القطاعات الانتاجية والخدمية في القطاع الخاص إلى القطاع العام، الذي لم يكن في الحقيقة بحاجة إليها، ولكن، لأسباب سياسية تتعلق بزيادة نفوذ الحزب الحاكم في مؤسسات الدولة، عبر تجنيد أكبر عدد ممكن من العراقيين في الأجهزة الحكومية، استخدمت الحكومة التوظيف لكسب الأتباع والضغط على المستقلين كي ينتموا إلى الحزب الحاكم.
وبفضل الفورة النفطية، إلى جانب التخطيط السليم، تمكنت الحكومة من تطوير البنية الأساسية للدولة خلال السبعينيات، فبنت المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والجامعات، وأرسلت البعثات الدراسية إلى الخارج لتعود إلى البلد وتساهم في نهضته. وما إن جاءت الثمانينات، بدأ الخراب يخيم على العراق، بعد أن دخل في حرب ضروس مع إيران. أصر الإيرانيون على مواصلتها ثماني سنوات، قُتل فيها أكثر من نصف مليون شاب عراقي، وجُرح وأُعيق ما يقارب المليون، بينما أُهدرت الدولة مئات المليارات على حرب عبثية لم تؤدِ إلى نتيجة ولم تحقق الغرض الذي اندلعت بسببه، فلم يتمكن العراق من استعادة شط العرب، ولم تتمكن إيران من إسقاط النظام العراقي. كانت حربا مدمرة، ويتحمل نتائجها من بدأها ومن أصر على مواصلتها رغم الجهود الدولية والإسلامية لوقفها.
وفي عقد التسعينيات، فُرضت على العراق عقوبات دولية قاسية إثر غزو النظام العراقي للكويت، ما دفع العالم إلى إرسال الجيوش لتحرير الكويت، لكنها دمرت العراق أيضا، وعاقبت العراقيين وأبقت على النظام. ساهمت العقوبات الدولية في تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للعراق، وجعلت معظم العراقيين فقراء لا يتعدى طموحهم العيش بكرامة وأمن. يضاف إلى كل هذه المآسي، تعرضُهم إلى القمع والملاحقة، ما دفع ملايين العراقيين إلى الهجرة. وطوال التسعينيات، ظل العالم يبحث عن أسلحة الدمار الشامل التي كانت قد دُمِّرت في الحروب وعلى أيدي المفتشين الدوليين، وفي النهاية جاءت الجيوش العالمية مرة أخرى (لتحرير العراق) هذه المرة من نظام صدام حسين، فأسقطته بسهولة غير متوقعة، وأقامت نظام حكم سمته ديمقراطيا، لكنه كان قائما على تفتيت الدولة وتقاسم السلطة والمال بين جماعات تسمي نفسها أحزابا سياسية، لكنها تمتلك أذرعا مسلحة.
وبمرور الزمن، تحول هذا النظام، إلى أداة طيعة بيد النظام الإيراني، الذي ساهم بشكل مباشر في زيادة التفتيت والتشرذم من خلال تأسيسه عشرات المليشيات المسلحة التي تأتمر بأمره وترتبط به أيديولوجيا وفعليا. فأصبح النظام الإيراني يمول كل نشاطاته المسلحة في اليمن ولبنان وسوريا والعراق من خلال تحكمه بالاقتصاد العراقي وإتيانه بأشخاص موالين له كي يديروا الدولة العراقية وكانت النتيجة إفلاس الدولة وإضعافها وتزايد أعمال النهب والقتل والخطف، ما دفع العراقيين إلى الثورة على النظام في تشرين الأول عام 2019. فكان رد هذا النظام (الديمقراطي) على الاحتجاجات هو دفع قناصيه وملثميه إلى الساحات والشوارع ليقتلوا ويخطفوا ويجرحوا ويعيقوا ما لا يقل عن ثلاثين ألف ناشط من شباب العراق، بينما بقي العالم يتفرج، ولم يقم بأي إجراء لمحاسبة القتلة ومن يقف وراءهم، سوى الاحتجاجات اللفظية.
تسلمت الحكومة الحالية السلطة في وضع صعب ماليا وأمنيا وسياسيا وصحيا، فأسعار النفط هبطت إلى النصف تقريبا، في وقت تجاوز عدد موظفي الدولة ومتقاعديها سبعة ملايين شخص. لم تكن هناك خيارات كثيرة أمام الحكومة، فموازانة العراق تعتمد على عائداته من النفط بنسبة تتجاوز 90%، ومازالت هذه الإيرادات قد تدنت إلى النصف، في وقت لا توجد مدخرات أو احتياطي نقدي كبير أو إمكانية سريعة لتنويع مصادر التمويل، فإن النتيجة الحتمية ستكون تخفيض العملة، شاءت الحكومة أم أبت، فهذه نتيجة طبيعية للتدهور الاقتصادي، خصوصا بوجود دين خارجي وداخلي هائل. فسعر العملة يعتمد ابتداء على متانة الاقتصاد وثقة الناس في الداخل والخارج به، ومتانة الاقتصاد تعتمد على رصانة الانتاج وحاجة المستهلكين، محليين وأجانب، إلى المنتجات التي ينتجها البلد، ومدى ديمومتها وقدرتها على الصمود أمام المنافسة الدولية لمنتجات مماثلة أو مشابهة.
وما زال العراق لا ينتج سوى النفط، فإن سعر عملته يعتمد على قدرته على التصدير وحاجة العالم إلى صادراته وحجم الاحتياطي النقدي الذي يمتلكه وقدرة البلد على الحفاظ عليه. وبسبب جائحة كورونا، واكتشاف مصادر جديدة للطاقة، تناقصت حاجة العالم إلى النفط. وكنتيجة، تضررت كل البلدان المصدرة للنفط، بما فيها التي تمتلك اقتصادات متنوعة، لكن ضررها كان بحجم مساهمة الصادرات النفطية في الاقتصاد الوطني. فإن كانت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي 20% فإنها تتأثر بنسبة مقاربة لها. أما البلدان التي يشكل النفط 90% من إيراداتها، مثل العراق، فإن تأثرها سيكون كبيرا، خصوصا إذا كانت غير مستقرة، وتعاني من انقسامات حادة وغير قادرة على تنويع الاقتصاد وتعظيم مواردها على نحو سريع، يقيها من تكبد أضرار كبيرة في اقتصادها.
كان سعر صرف الدينار العراقي مستقرا تقريبا خلال 15 سنة بحوالي 1200 دينار للدولار، لكن هذا السعر مرتفع مقارنة بإيرادات العراق وقوة اقتصاده ودرجة استقراره، وهو أيضا يضر بالاقتصاد، لأنه أبقى أسعار الوارادت منخفضة في وقت لم تكن المنتجات الوطنية قادرة على منافستها. لقد كان السعر مرتفعا، ليس بسبب قوة الاقتصاد العراقي وثقة المنتجين والمستثمرين والمستهلكين به، بل لأن السعر يتماشى مع سياسة الحكومة، إذ كانت الدولة تنفق أموالا طائلة على دعم سعر الدينار، بلغت في إحد السنين 50 مليار دولار. المشكلة الكبرى في هذا الموضوع أن الكثير من التعاملات التجارية التي كانت تقدمها البنوك والشركات إلى البنك المركزي كي تحصل منه على العملة الأجنبية، غير حقيقية، والهدف منها هو تحويل الأموال المستحصلة عبر ممارسات فاسدة إلى العملة الصعبة ثم تحويلها إلى الخارج.
وكنتيجة للدعم الحكومي لسعر الدينار ومساهمة ذلك في خفض أسعار الواردات، أصبح العراق يستورد كل شيء، ابتداء من الماء واللبن والفواكه والخضروات، إلى المشتقات النفطية والكهرباء والغاز والأدوية والإسمنت والطوب والألبسة واللحوم والأسماك، بينما يمكن إنتاج كل هذه المواد محليا، بل كان العراق ينتجها ويصدر بعضها. لقد أضرت الوارادات الرخيصة كثيرا بالاقتصاد الوطني وساهمت في تدميره ودفعت الناس جميعا للعمل في مؤسسات الدولة، بينما انتفع مهربو العملة والسماسرة والسياسيون المتنفذون الذين سهلوا هذه العملية، بوالطبع الدول المصدرة للبضائع.
لقد طالب كاتب السطور مرات عدة بخفض قيمة الدينار المرتفعة من أجل أن تحفيز الاقتصاد الوطني على الإنتاج، والذي سيقود إلى تنويع مصادر الدخل والحد من الممارسات الفاسدة المبنية على استحصال العمولات من الشركات المستوردة للبضائع والسلع. وكانت آخر مطالبة ضمن محاضرة في جامعة لندن قبل عامين تقريبا، وقد بعثت بتسجيلها إلى الأستاذ علي علاوي وزير المالية الحالي، الذي كان حينها مرشحا لمنصب محافظ البنك المركزي. وقد رد الأستاذ علاوي قائلا إن كل ما قلته في المحاضرة صحيح، وإن مزاد العملة يحتاج إلى مراجعة وإن الاقتصاد لن يتعافى إن استمرت الأوضاع على هذا المنوال.
أخيرا قررت وزارة المالية، تحت ضغط السوق، خفض قيمة الدينار إلى 1450 دينار مقابل الدولار في موازنة عام 2021، وتبعها البنك المركزي الذي رفع سعر الدولار إلى 1460 دينار، بينما حدد سعر الدولار للبنوك التجارية بـ 1470 دينار. إن خفض قيمة العملة إجراء في الاتجاه الصحيح ومن شأنه أن يساهم في تحسين الإنتاج الوطني وتقليص الأضرار الناتجة من تهريب العملة، ومساعدة الحكومة في دفع رواتب موظفيها، إذ يقلص حاجتها إلى الاقتراض، لكن الخطورة تكمن في أن القوة الشرائية للدينار سوف تتدنى محليا أيضا، وسوف ترتفع أسعار المواد المستوردة، بنسبة تقارب نسبة التخفيض وهي 18% حاليا.
قد يتدنى سعر الدينار إلى 1500 للدولار (21%) أو أكثر في المستقبل إن لم تتمكن الحكومة من تعظيم موارد الدولة وتعيد الثقة إلى الاقتصاد. المطلوب الآن من الحكومة العمل على وقاية الطبقات الفقيرة من تأثيرات انخفاض سعر العملة، على الأقل حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من الاستجابة للطلب على بدائل الواردات، التي سينتعش سوقها دون شك، خصوصا إذا كانت أقل كلفة وأعلى جودة من مثيلاتها المستوردة. وتتجسد الوقاية في زيادة الرواتب المتدنية للموظفين والمستفيدين من مساعدات شبكة الحماية الاجتماعية، بنسبة 25%، كي تدرأ عنهم أضرار خفض سعر العملة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل كل الفقراء في الدولة، وهذا بدوره ينعش الإنفاق الاستهلاكي الذي يعود بعوائد جديدة على الدولة والأنشطة التجارية ويحفز الإنتاج الصناعي والزراعي. والمطلوب قبل هذا وذاك هو البدء بمكافحة الفساد وإيقاف النهب العلني لأموال الدولة عبر الاستيلاء على المنافذ الحدودية والموانئ وتهريب النفط وتقاضي الرشاوى لقاء التعيين في وظائف الدولة والتنقل بينها.
على الأمد البعيد، يجب اتخاذ خطوات جادة في دعم الصناعة والزراعة والسياحة، وهي القطاعات الثلاثة التي يمكن أن تعوض عن عائدات النفط. القطاع الزراعي يمكن تحفيزه بسرعة لأن مقوماته متوفرة (أرض ومياه وفلاحون). لكن قطاعي الصناعة والسياحة يحتاجان إلى وقت واستثمارات كبيرة كي يتطورا ويأتيا بعوائد جيدة. ولكن يمكن الدولة أن تنظم السياحة الدينية على وجه السرعة، بحيث تحدد عدد الزائرين في المناسبات الدينية، بحيث لا يكون العدد مُربِكا لحياة العراقيين، وتفرض رسوما مناسبة لقاء تأشيرات الدخول، وتوفر البنى الأساسية المطلوبة لتنظيم هذا القطاع، كي يدر موارد على الدولة، وتقلص من الفوضى التي تسوده حاليا، خصوصا شيوع عادات تضر بالاقتصاد وتربك قطاع السياحة مثل جمع الاموال لإطعام السياح وإيوائهم مجانا، بينما يدفع السياح تكاليف سفرهم ومصاريفهم في الدول الأخرى، وبذلك تساهم السياحة في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط التجاري. السياحة المجانية السائدة حاليا تربك الاقتصاد والأمن وحياة السكان جميعا، وقد آن الأوان لتنظيمها بما يتلاءم مع مصلحة البلد.