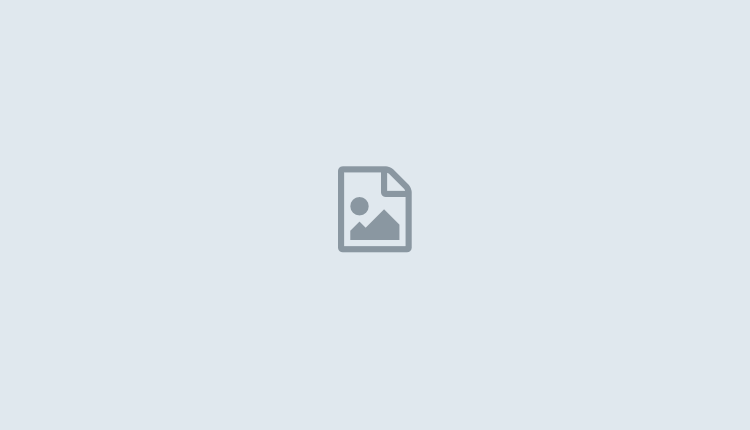الرابح والخاسر في الصراع الأميركي الصيني
حميد الكفائي
على الرغم من التوتر الذي يسود العلاقات الصينية-الأميركية، إلا أن الرئيس جو بايدن، لم يسارع إلى الاتصال بنظيره الصيني، شي جينبينغ، إلا بعد ثلاثة أسابيع من توليه الرئاسة، بينما تحدث إلى معظم رؤساء الدول المهمة خلال الأسبوع الأول.
وعندما تحدث الرئيسان لساعتين، لم تسفر محادثتهما عن نتيجة، إذ ظلا متمسكيْن بمواقفهما، ما يعكس عمق الخلافات وحِدّة التنافس بين بلديهما. لكن أهمية العلاقات تستدعي إيجاد حلول تحفظ الحد الأدنى لمصالح الطرفين، وتجنِّب العالم صراعا مدمرا وفائضا عن الحاجة.
كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنكن، قد مهد إلى تلك المكالمة بين الرئيسين عندما سارع لإجراء مكالمة هاتفية مع مسؤول دبلوماسي صيني رفيع، يانغ جيشي، بُعَيد تأكيده وزيرا للخارجية. غير أن تلك المحادثة هي الأخرى لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية، إذ لم يتفق الرجلان حتى على ترتيب المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومازال البلدان يُشهِران الأسلحة المتاحة لكل منهما ضد الآخر، ما يعني أن خلافاتهما ليست طارئة، بل مصيرية وتتعلق بمستقبل كل منهما كقوة عظمى.
الجانب الأميركي ظل يؤكد على أهمية التزام الصين بحقوق الإنسان، ويحملها المسؤولية عن زعزعة الاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا، بينما تؤكد الصين على أهمية عدم التدخل في شؤونها الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بهونغكونغ وتبت وشينبيانغ، التي تقطنها أقلية اليوغور المسلمة، التي تتعرض للاضطهاد منذ سنوات. كما تؤكد الصين على حساسية علاقتها بتايوان (الصين الوطنية سابقا) والتي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ولطالما عبَّرت عن انزعاجها من العلاقة الوثيقة بين واشنطن وتيبي، التي تحتمي بالولايات المتحدة من التهديد الصيني.
وكالة شنوا الصينية الرسمية ذكَّرت الأميركيين بضرورة الأخذ بنصيحة هنري كيسنجر، المؤسس الحقيقي للعلاقة الأميركية-الصينية في سبعينيات القرن الماضي، الذي قال “إن على الولايات المتحدة والصين ألا يهزا العالم بل يبنيانه”، لكن هذا الكلام ظل نظريا، فقد تسابق البلدان للتفوق على بعضهما البعض، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
كان بايدن قد وصف الرئيس شي في حملته الانتخابية بأنه “سفاح”، في إشارة إلى قمعه شعوب اليوغور وهونغ كونغ وتبت، لكنه دعا في كلمة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بعد حديثه مع الزعيم الصيني، إلى تجديد البنى الأساسية الأميركية لمواجهة الصين، التي وصفها بأنها “أهم منافس للولايات المتحدة”، وحذر من “استيلاء الصين على حصتنا من التجارة العالمية”، قائلا إنها “ستأكل غدانا”! مضيفا أن الصين تستثمر أموالا طائلة في مجالات النقل والبيئة وقطاعات أخرى “ولابد للولايات المتحدة من أن ترتقي في استثماراتها وتقنياتها كي تتمكن من المنافسة”. ووعد بايدن بأن الولايات المتحدة في ظل رئاسته سوف تتفوق على الصين وتبقى زعيمة للعالم “ليس عبر نموذج قوتنا فحسب، وإنما عبر قوة نموذجنا”.
الزعيم الصيني دعا إلى علاقة يكون فيها الطرفان رابحيْن، لكنه كرر مطالبته واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين، محذرا من “الكارثة” التي ستحل بالعالم في حال اصطدمت الصين بالولايات المتحدة، معتبرا كل ما يحصل في هونغ كونغ وتيبت وشينجيانغ أمرا داخليا! أما قضية تايوان فاعتبرها “مرتبطة بالسيادة الصينية”، الأمر الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا، فتايوان دولة مستقلة منذ سبعين عاما، وإن لم تكن حاليا عضوا في الأمم المتحدة، التي منحت مقعدها للصين الشعبية عام 1971!
لكن القوة الصينية المتصاعدة، والسعي نحو النفوذ العالمي المتمثل بسياسة خارجية نشيطة وخطط اقتصادية بعيدة الأمد، لا تقلق واشنطن فحسب، وإنما تقلق دولا أخرى كالهند واليابان وفيتنام وأستراليا. فالصين تحاول منذ عشر سنوات أن تتحرر من النظام المالي الأميركي، عبر إقامة مشاريع مشتركة بين مؤسساتها المالية والمؤسسات المالية العالمية، غير المرتبطة بالولايات المتحدة، مثل نظام التسديد المالي (سويفت)، الذي يعتبر الأوسع عالميا. وهذه المشاريع المشتركة ستجعل الصين أقل اعتمادا على النظام المالي الأميركي المعتمِد على الدولار.
لقد استثمرت الصين 1.3 ترليون دولار، حسب تقديرات بنك مورغان ستانلي، في إنشاء ما سمي بـ “طريق الحرير الجديد” أو “مبادرة الحزام والطريق”، التي تتضمن شبكة من الطرق والمعابر والموانئ وسكك الحديد، لربط آسيا بأوروبا، والذي أعلنت 60 دولة عن رغبتها في المشاركة فيها. ويعتقد مراقبون بأن الصين تسعى لتحرير نفسها من الهيمنة الاقتصادية الأميركية أولا، ثم توسيع نفوذها الاقتصادي في آسيا وأروبا. لذلك أنشأت مؤسسات مالية منفصلة مثل “بنك آسيا للاستثمار في البنى الأساسية”، وأقامت تحالفات جديدة مُبعِدة منها الولايات المتحدة، مثل “الشراكة الاقتصادية الشاملة” التي تضم 15 دولة في منطقة المحيط الهادئ وآسيا، وتضم دولا حليفة لواشنطن كاليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية. ويُعتقَد بأن هذا التحالف يهدف إلى وقاية الصين من المؤثرات الاقتصادية الأميركية.
كما استَبَقت الصين جهود الرئيس الأميركي لتعزيز العلاقات مع الحلفاء في أوروبا، عبر إبرامها صفقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وروسيا، وفي الوقت نفسه، الإعلان عن استعدادها للعمل البنّاء مع إدارة بايدن، مطالبة بأن تبدأ واشنطن بتحسين العلاقات مع الصين، وتتجنب الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة السابقة. لذلك فإن السياسة الأميركية القائمة على “مقاربة الصبر”، حسب وصف الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد تلحِق ضررا بجهود الإدارة الجديدة الرامية لإعادة ترتيب صفوف الحلفاء، كي يتخذوا موقفا متقاربا من الصين. كما أن التلكؤ في الاتفاق مع الصين سوف يمكِّن الجمهوريين من توظيفه والادعاء بأن سياسات الإدارة الجمهورية السابقة كانت صحيحة.
لكن إقدام الصين على احتجاز مليون شخص من طائفة اليوغور المسلمة، قد أحرجها عالميا، خصوصا مع البلدان الغربية والإسلامية، رغم أنها تبرر هذا الاحتجاز بأنه بهدف “التدريب المهني ومكافحة الإرهاب”! كما أن ممارسة القمع وإلغاء المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ، قد ساهم في توتير العلاقة مع الدول الغربية، التي تعتبر الديمقراطية قضية أساسية من نواح سياسية واقتصادية، لأن الديمقراطية تعني بالنسبة للغرب، الانفتاح على الآخر، واتباع النظام الرأسمالي الذي يسمح بالتنافس التجاري والصناعي، لذلك فإن ما تمارسه الصين من قمع وفرض للقيود في هونغ كونغ، التي عاشت في ظل نظام رأسمالي غربي لمئة عام، أثناء تبعيتها لبريطانيا، سوف يضر بمصالح الدول الغربية، واحتمالات التنافس الجاد، مع الصين.
كذلك فإن قيام الصين بمنع شركات أميركية عالمية، مثل غوغل وفيسبوك والشركات الأخرى التابعة لهما مثل واتساب وإنستغرام ومسنجر، من العمل في أسواقها، قد ساهم في توتير العلاقة مع الولايات المتحدة والإيحاء بأن الصين تأخذ ولا تعطي.
لا توجد أوهام لدى القيادة الصينية بخصوص العلاقة مع الولايات المتحدة، فالانقسام السياسي والمجتمعي الحاد، سوف يعرقل الاتفاق الشامل لتحسين العلاقة مع الصين، بينما تنشغل وسائل الإعلام الصينية بانتقاد السياسة الأميركية، واصفة المجتمع الأميركي بالممزق. وما يؤكد مخاوف الصين هو اعتراض اليمين الجمهوري على تعيين جينا ريموندو وزيرة للتجارة، وليندا توماس-غرينفيلد، مندوبة لدى الأمم المتحدة بسبب “مواقفهما غير المتشددة من الصين”!
التضارب في السياسة الخارجية الأميركية خلال العقدين المنصرمين، خصوصا ما حصل في ظل رئاسة دونالد ترامب، قد أضعف ثقة العديد من الدول، الحليفة والمنافِسة على حد سواء، بالولايات المتحدة كحليف استراتيجي أو شريك تجاري يمكن التنبؤ بسياساته. فالصين، على الأقل منذ مطلع التسعينيات، سلكت سلوكا يمكن التنبؤ به، وهو اتباع اقتصاد السوق مع الإبقاء على النظام الشيوعي كنظام سياسي. والحال نفسها تنطبق على دول أخرى، كروسيا والاتحاد الأوروبي ودول أوروبا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط.
وإن كانت ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة قد اهتزت، بسبب سياسة الرئيس ترامب، “وأن هناك حاجة لإعادة بناء الثقة بين أوروبا والولايات المتحدة” كما جاء في تصريح السكرتير العام لحلف الناتو، جينز ستولتينبيرغ، فكيف يمكن الخصوم أن يحددوا مواقفهم منها، على الرغم من أن الثقة العالمية بالرئيس الجديد، حسب استطلاع أجرته وكالة “آيبسوس” في 24 دولة، تتفوق على سلفه بمعدل (48 إلى 17). وكان أعضاء حلف الناتو قد صُدموا بتصريح ترامب بأن حلف الناتو أصبح “ميتا”، وإعلانه بأنه سينسحب منه!
لكن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجديدة قد عززت من صدقيتها، ففي الأسبوع الأول لوصولها إلى السلطة، أعادت عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، وقررت دعمها ماليا من أجل مكافحة فيروس كوفيد19، وهذا الإجراء ضروري، فلا يمكن القضاء على الفيروس بجهود منفردة، وهناك حاجة لتضافر الجهود العالمية للقضاء عليه. كما عادت إلى اتفاقية باريس للمناخ، وألغت الحظر على سفر المسلمين إلى أميركا، وأوقفت بناء الجدار في حدودها مع المكسيك، وأعلنت عزمها على تعزيز العلاقات مع حلفائها والتشاور معهم في القضايا المهمة.
لكن دولا كروسيا لا ترى تغيرا أساسيا في الموقف الأميركي تجاهها، بحسب الباحث ديمتري سوسلوف، الذي تنبأ بأن الاستقطاب في الولايات المتحدة الذي تأجج خلال السنوات الأربع المنصرمة، لن يختفي سريعا، وأن بايدن لا يمتلك تفويضا واسعا للحكم. ويتوقع سوسلوف بأن روسيا ستتجنب أي اصطدام بالولايات المتحدة، لكنها سوف تحسن علاقاتها بالصين والهند.
مازالت الصين تعتبر الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة في العالم، والشريك التجاري الأكبر لها، وهي تبذل مساعي حثيثة لإقناع المؤسسات الاقتصادية والسياسية الأميركية، بأن الصين لا تعتزم الحلول محل الولايات المتحدة في العالم، ولا تسعى لأن تصدَّر نموذجها الاقتصادي، ولا إلى مواجهة أيديولوجية، وهذا بالضبط ما قاله يانغ جيشي، مدير مفوضية الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، مطلع الشهر الجاري.
وتسعى الصين عبر تقديم هذه التطمينات إلى كسب ثقة الشركات الأميركية إلى جانبها، من أجل رفع القيود والعقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة، والتي تضمنت فرض تعرفات جمركية بقيمة 350 مليار دولار على الصادرات الصينية، وحظر استيراد القطن والمنتجات الزراعية من منطقة شينجيانغ التي يُضطَهَد فيها المسلمون اليوغور، ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع شركات الاتصالات والمؤسسات العسكرية الصينية.
وقد أبدت الشركات الأميركية رغبتها في التعامل مع الصين، بينما طالبت غرفة التجارة الأميركية بتخفيف التوتر معها. وتمكنت شركات صينية من إيقاف قانون حقوق الإنسان في يوغور في مجلس الشيوخ، رغم إقراره بالإجماع في مجلس النواب. لا شك أن إدارة بايدن سوف تتوصل إلى اتفاق مع الصين، فهناك مصلحة للبلدين في تخفيف التوتر واستئناف التعامل التجاري.
لكن خشية البلدين من بعضهما عميقة ولن تزيلها الاتفاقيات. الولايات المتحدة تخشى التمدد الصيني على مناطق نفوذها، وسرقة تكنولوجياتها واستخدمها للتنافس معها، بينما تسعى الصين حثيثا لإضعاف النفوذ والهيمنة الأميركيين على الاقتصاد العالمي. وعلى قول أحد الباحثين الأميركيين، “على الولايات المتحدة ألا تخشى سرقة الصين للتكنولوجيا الأميركية، لأنها ستمارس الشيء نفسه مع الصين قريبا”! لا شك أن الطرفين سيخسران إن استمرت هذه المواجهة، كما أن الدول الأخرى ستضطر للاصطفاف مع إحداهما ضد الأخرى، وهذا يضعف كلتيهما ويزيد كلفة الصراع. المصلحة المشتركة تحتم إزالة القطيعة، وهذا ما سيحصل في ظل رئاسة بايدن، أما الخلاف فسيبقى بصورة عديدة، وإن خفت حدته ظاهريا.